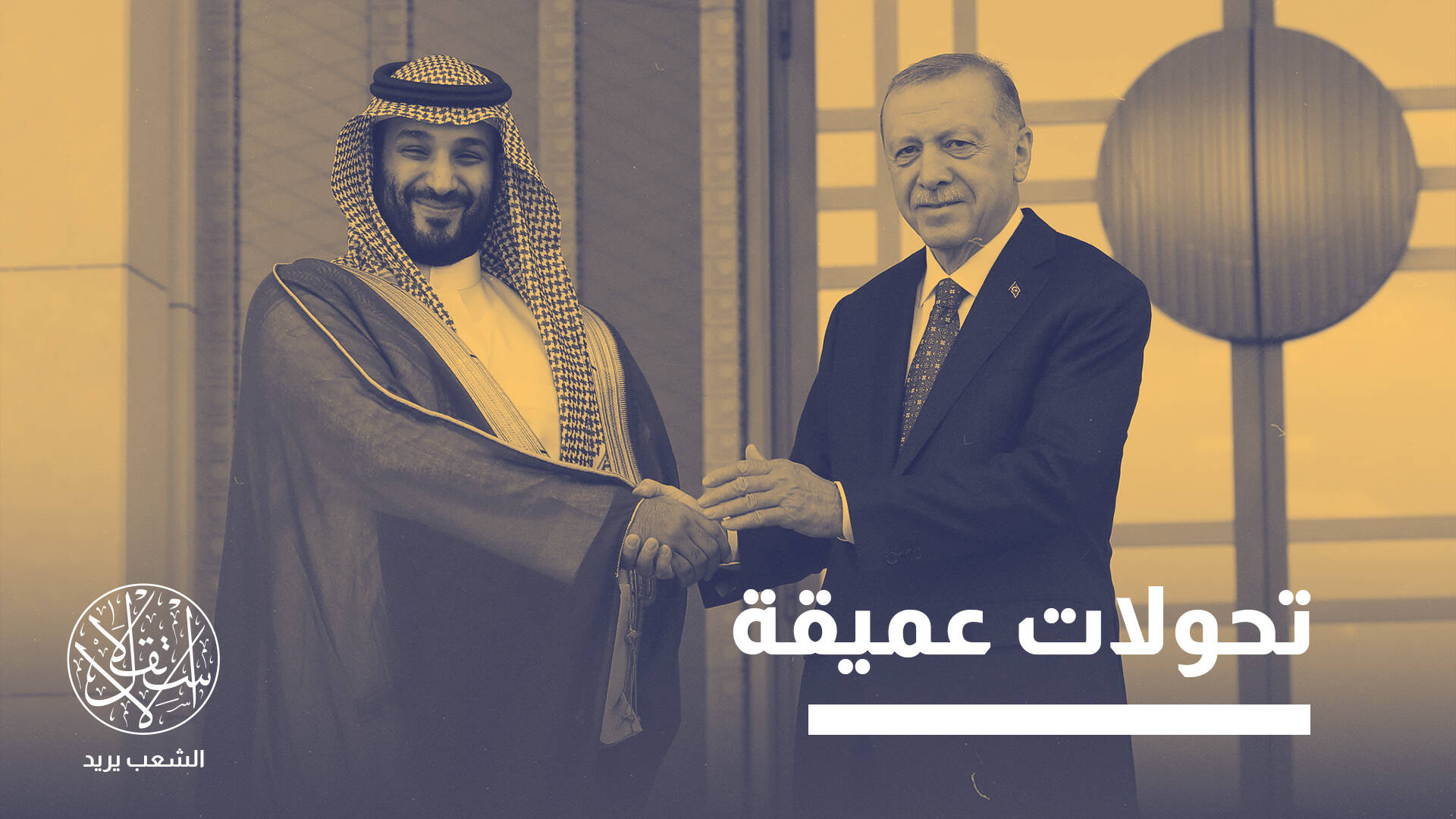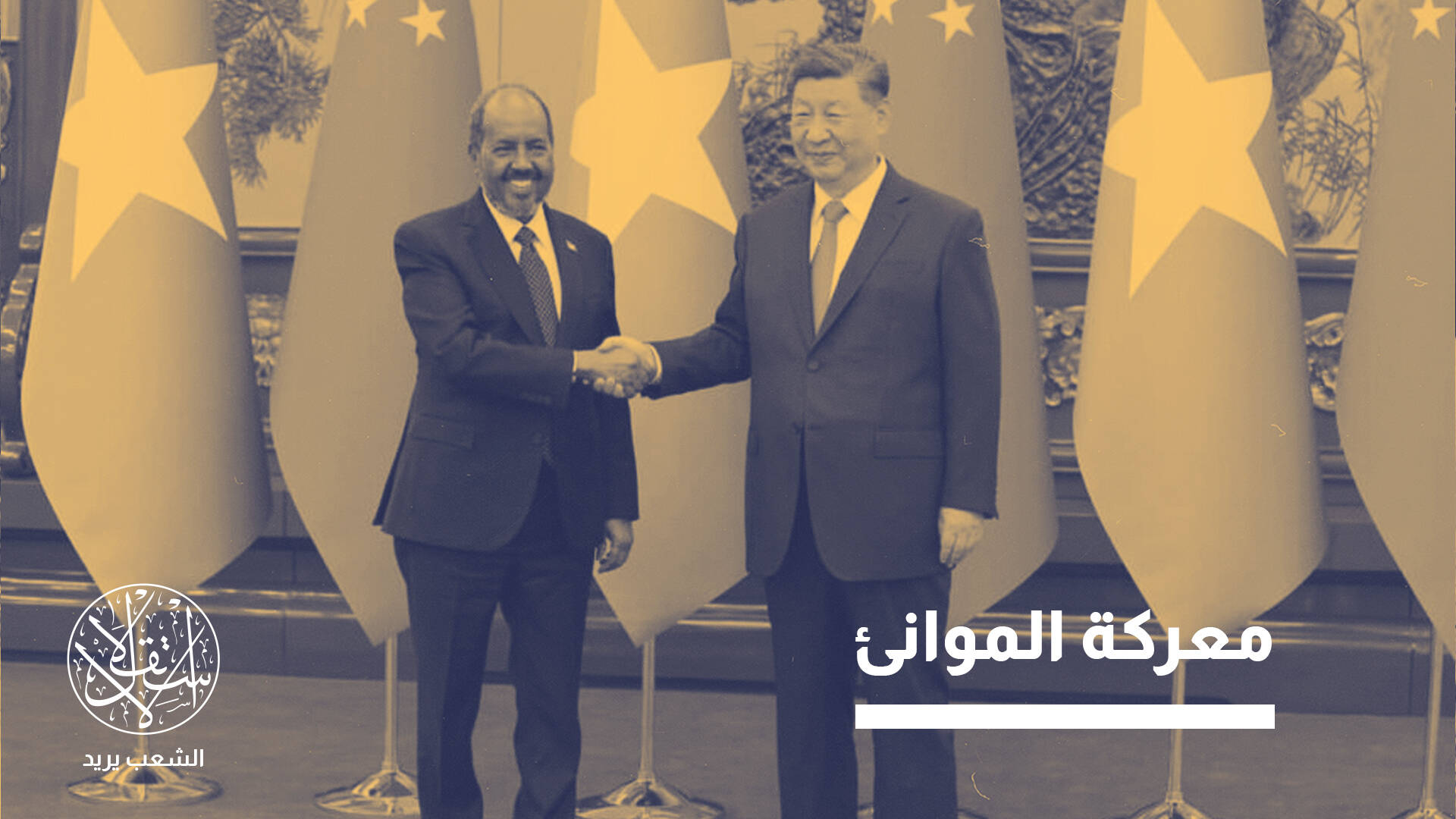انقلاب على واشنطن واشتباك مع أبو ظبي.. لماذا يفكّك ابن سلمان تحالفاته القديمة؟

الرياض باتت تنظر إلى إسرائيل باعتبارها "المشكلة المركزية في الشرق الأوسط"
بالتزامن مع اشتباك إعلامي متصاعد بين الرياض و"حكومة أبو ظبي"، كما تصفها وسائل إعلام سعودية، على خلفية ما تعده المملكة إضرارًا إماراتيًا بأمنها القومي عبر مغامراتها في اليمن والسودان، شهدت السعودية سلسلة تحولات لافتة تشير إلى أن الصراع مع محمد بن زايد بات يتقدم على أولويات ولي العهد محمد بن سلمان.
فقد أفرجت السلطات السعودية عن عدد من كبار العلماء الذين سبق اعتقالهم في سياق الصراع مع التيار الإسلامي، وهو مسار تقاطعت فيه سياسات الرياض مع أبو ظبي والقاهرة خلال السنوات الماضية.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة للاستفادة من ثقل هؤلاء العلماء وتأثيرهم المجتمعي، في ظل المواجهة السياسية المتنامية مع الإمارات.
وفي السياق ذاته، وبعد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروع "نيوم"، تتجه السعودية، وفق تقارير صحيفتي فايننشال تايمز وإندبندنت البريطانيتين، إلى تقليص طموحات المشروع العملاق وإعادة تعريف أهدافه، في اعتراف ضمني بإخفاق الرؤية السابقة أو على الأقل بعدم واقعيتها في صيغتها الأولى.
على صعيد آخر، أشارت مجلة ناشيونال إنترست إلى ما وصفته بتغيير في "قواعد اللعبة" السعودية، لافتة إلى أن واشنطن بدأت تدرك أن المملكة لم تعد مشروعا أميركيا سهل الإدماج في مسار اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".
ويعكس ذلك، بحسب المجلة، تحوّلًا في الحسابات الإستراتيجية، إذ لم تعد الرياض مستعدة للتموضع داخل المعسكر الإسرائيلي أو لعب دور التابع في الترتيبات الإقليمية، بل تسعى إلى إعادة تعريف دورها من موقع الفاعل المستقل القادر على المناورة وفرض شروطه.
وبهذا المعنى، يبدو أن الرهان التقليدي على السعودية، بوصفها ركيزة ثابتة في السياسات الأميركية بالمنطقة، قد انتهى بصيغته القديمة، لصالح مقاربة سعودية جديدة تقوم على تنويع التحالفات وإعادة رسم موقع المملكة في معادلات الإقليم.

مشروعات وهمية
شكّل إصرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على المضي قدما في مشروع "نيوم"، رغم ما وُصف بأنه حلم غير واقعي ومشروع مكلف ذو تداعيات مالية وسياسية جسيمة، أحد أكثر ألغاز مرحلة حكمه إثارة للجدل. غير أن الأمير الشاب، المرشح لتولي العرش، عاد وتراجع عن المشروع بالتزامن مع تصاعد التوتر مع الإمارات، وقرّر تقليصه بشكل كبير.
وبحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في 25 يناير/كانون الثاني 2026، أجرى الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس مجلس إدارة "نيوم"، عملية تقليص واسعة وإعادة تصميم شاملة للمشروع، مع اقتراب انتهاء مراجعة خطط التطوير بعد سنوات من التأخير وتجاوز الميزانيات المقررة.
وأفادت الصحيفة بأن مشروع "ذا لاين"، الذي كان من المتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو 500 مليار دولار، سيشهد خفضًا كبيرًا في حجمه ضمن الخطط المعدّلة، دون تحديد واضح لنسبة هذا التقليص.
وقد جاء ذلك بعد تعثّر مشروع منظومة النقل المستقبلية التي تقوم عليها المدينة، والتي كانت تعتمد على وسائل تنقّل فائقة السرعة تشبه الصواريخ، ما أدى عمليا إلى انهيار فكرة بناء مدينة بطول 100 ميل في قلب الصحراء، وانعكس سلبًا على طموحات السعودية السياسية والاقتصادية.
من جهتها، أكدت صحيفة إندبندنت البريطانية، في تقرير بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2026، أن السعودية ستُقلّص بشكل كبير حجم مشروع "نيوم" وخططها لإنشاء مدينة صحراوية عملاقة، في ظل مخاوف متزايدة من التكاليف الباهظة والتأخيرات المتكررة.
وكان من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2030، إلا أن أعمال البناء توقفت أواخر العام الماضي، بينما بدأت الرياض البحث عن نهج بديل أقل كلفة وأكثر واقعية.
ولم يقتصر التقليص على "نيوم" فحسب، إذ جرى أيضًا تأجيل مشروع “تروجينا” الذي يقوم على فكرة إنشاء منتجع تزلج جبلي داخل المشروع، كما علّقت الحكومة السعودية العمل على "مشروع المكعب". وفق ما أفادت به وكالة رويترز في 27 يناير/كانون الثاني 2026.
ويُعد "المكعب" مشروعا سياحيا ضخما كان مخططا له أن يضم نحو 80 منطقة ترفيهية في الرياض، وتُقدّر تكلفته بنحو 50 مليار دولار. وكان من المفترض إنجازه بحلول عام 2030، قبل أن يُؤجّل إلى عام 2040، وسط حديث عن تقليصه إلى نسخة "أصغر بكثير".
وقد أثار تصميمه جدلًا واسعًا عند الكشف عنه، بسبب تشابهه مع الكعبة المشرفة، قبل أن تتراجع الحكومة عن المضي قدمًا فيه بصيغته الأصلية.
واتسعت خلال الفترة الأخيرة موجة إلغاء أو تقليص المشاريع الضخمة والمكلفة في السعودية، من "نيوم" إلى مشاريع ملاعب كأس العالم، في ظل تحوّل واضح عن الإنفاق الاستعراضي الذي هيمن على "رؤية 2030"، لصالح مشاريع أكثر إلحاحًا وربحية، خاصة مع شح السيولة وتراجع أسعار النفط.
ويعاني الاقتصاد السعودي من تبعات عقود من الإنفاق المرتفع، إلى جانب الضغوط الناجمة عن انخفاض العائدات النفطية، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية.
وفي هذا السياق، رصدت وكالة بلومبيرغ في 28 يناير/كانون الثاني 2026 تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 التي كانت تمثل حدثا استعراضيا بارزا في طموحات المملكة الرياضية، لكنها واجهت تعقيدات تقنية وتكاليف مرتفعة، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء منحدرات تزلج في بيئة صحراوية.
ويعكس هذا التراجع عملية إعادة ضبط يقودها صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر أصوله بنحو تريليون دولار، بالتنسيق مع الحكومة المركزية، مع تركيز الموارد على مشاريع بنية تحتية ذات مواعيد نهائية لا يمكن تعديلها، مثل "إكسبو 2030" وكأس العالم 2034.
وفي هذا الإطار، قال صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2025: إن "القرار الأخير بإعادة ترتيب أولويات بعض مشاريع الاستثمار الكبرى أسهم في تركيز الإنفاق على المجالات الأكثر أهمية، وحدّ من مخاطر ارتفاع درجة سخونة الاقتصاد".

سر الإفراجات
منذ سبتمبر/أيلول 2017، وبالتزامن مع الحصار الذي فرضته السعودية وحليفاتها (الإمارات ومصر والبحرين) على قطر في يونيو/حزيران من العام نفسه، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات وملاحقات واسعة استهدفت علماء ودعاة ومفكرين وأكاديميين بارزين.
وبحسب ما أورده موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت "مواطنون بلا حدود"، بلغ عدد المعتقلين قرابة 70 شخصًا من العلماء والدعاة والأكاديميين، في واحدة من أوسع حملات الاعتقال التي شهدتها المملكة في تاريخها الحديث.
وكان من أبرز المعتقلين آنذاك: سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وأحمد بن عبد الرحمن الصويان، والإمام إدريس أبكر، إلى جانب منع آخرين من السفر دون اعتقالهم.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2025، وخلال يناير/كانون الثاني 2026، بدأت السلطات السعودية بالإفراج عن عدد من هؤلاء المعتقلين، وفق أنباء متضاربة بين النفي والتأكيد، دون صدور أي إعلان رسمي يوضح طبيعة هذه الإفراجات أو أسبابها.
وشملت الإفراجات، بحسب ما تداوله ناشطون ووسائل إعلام، مشايخ ودعاة من بينهم: خالد الراشد، وناصر العمر (مع نفي منتدى العلماء الإفراج عنه)، ومحمد عبد العزيز الخضيري، ومحمد الهبدان، والدكتور مالك الأحمد، وبدر المشاري، والدكتور إبراهيم الحارثي، والداعية عبد العزيز الطريفي، وسط حديث عن توقع إطلاق سراح أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأثار هذا التطور تساؤلات واسعة لدى المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين، لا سيما في ظل غياب الشفافية الرسمية، وصعوبة تفسير هذه الإفراجات بوصفها تحوّلًا حقيقيًا أو جادًا في نهج السلطات تجاه ملف الحريات العامة.
وفي تحليل نشره موقع "القسط" المعني برصد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2026، أُشير إلى أن موجة الإفراجات التي بدأت أواخر عام 2024 ترتبط بمحاولات المملكة تحسين صورتها الدولية، وتقديم نفسها بوصفها مركزًا عالميًا للفعاليات الاقتصادية والرياضية والترفيهية، فضلًا عن تصاعد الضغوط الحقوقية الخارجية.
ورجّح التقرير أن تكون الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034، إلى جانب عدد من الفعاليات الدولية الكبرى التي تحتضنها المملكة، من بين أبرز دوافع هذه الإفراجات، نظرًا لما يفرضه ذلك من تدقيق متزايد في سجل السعودية الحقوقي.
كما أشار إلى أن الضغط الحقوقي المتنامي دفع السلطات إلى الإفراج عن عدد محدود من المعتقلين، مع الإبقاء على قيود مشددة بحقهم، تشمل حظر السفر، والمنع من العمل، وفرض الإقامة الجبرية غير المعلنة، وحرمانهم من بعض الخدمات الحكومية والمالية، رغم الإفراج الرسمي عنهم.
ومع استمرار الإفراجات خلال يناير/كانون الثاني 2026، برزت تقديرات أخرى تربط هذه الخطوة بتصاعد التوتر في العلاقات السعودية الإماراتية. ولاحظ مراقبون في هذا السياق تداول حسابات قريبة من الإمارات تغريدات تشير إلى "إطلاق سراح رجال دين إخوان في السعودية"، في دلالة على توظيف سياسي محتمل لهذا الملف ضمن الصراع الإقليمي المتصاعد بين الطرفين.
وأفرجت السعودية عن أكثر من 30 معتقلا سياسيا من سجونها منذ سبتمبر/أيلول 2024، معظمهم من سجناء الرأي، وفق إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 22 مارس/آذار 2025.
وارتفع عدد المفرج عنهم بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025 إلى ما لا يقل عن 44 سجينًا، من بينهم ناشطون وطلاب دراسات عليا، مثل سلمى الشهاب ومحمد القحطاني، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2025.
وفي كثير من الحالات، كان المفرج عنهم قد أنهوا بالفعل مدد محكومياتهم، بل وتجاوزوها أحيانًا، قبل إطلاق سراحهم، كما في حالة محمد فهد القحطاني، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).
وفي حالات أخرى، أنهى المعتقلون مدة حكم أولى، ثم أُعيدت محاكمتهم وإدانتهم مجددًا، وقضوا أحكامًا إضافية كاملة، قبل الإفراج عنهم بعد أشهر أو حتى سنوات من انتهاء تلك المدد، كما حدث في قضية عيسى النخيفي.
كما شهدت بعض القضايا تخفيفًا جزئيًا لأحكام بالغة القسوة نتيجة ضغوط دولية مكثفة، لا سيما في قضية سلمى الشهاب، التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات، قبل أن تُرفع العقوبة إلى 34 عامًا، ثم جرى تخفيض الحكم لاحقًا والإفراج عنها عام 2025.
وفي عدد من الحالات، أُبلغ المعتقلون بالإفراج عنهم بشكل شخصي، من دون صدور أي إعلان رسمي عن عفو ملكي، فيما لم يُعلن عن عفو بحق آخرين، ولم تُلغَ الأحكام الصادرة ضدهم رسميًا.
وفي المقابل، لا يزال العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية أن الانتهاكات الحقوقية في السعودية لم تتوقف، رغم موجات الإفراج المحدودة.

رفض التطبيع
تزامن تصاعد الخلافات بين السعودية والإمارات مع تسارع وتيرة التقارب بين أبو ظبي وتل أبيب، مقابل ابتعاد الرياض عن هذا المسار، واتجاهها نحو تعزيز علاقاتها مع كل من تركيا وإيران. وقد رصدت صحف أميركية ومراكز أبحاث هذا التحول، وعدته ابتعادا سعوديا متزايدا عن الرؤية الأميركية بشأن التطبيع مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، نشرت مجلة "ناشيونال إنترست"، القريبة من دوائر التفكير في واشنطن، مقالا لافتا بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2026، عُدّ مؤشرًا مهمًا على طبيعة التفكير داخل مراكز النفوذ الأميركية.
وأوضح المقال أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبتعد تدريجيًا عن الولايات المتحدة، ويسير في اتجاه معاكس لتوقعاتها، لا سيما في ما يتعلق بالتقارب السعودي–الإسرائيلي، داعيًا واشنطن إلى إعادة النظر في افتراضاتها التقليدية حيال المملكة.
وأشار إلى أن السعودية كانت، في مرحلة سابقة، ترى في إيران تهديدا رئيسا يسعى للهيمنة على المنطقة، ما دفعها للتقارب مع واشنطن وتل أبيب، وفتح الباب أمام نقاشات حول التطبيع، خصوصا في سياق الحصول على أسلحة متقدمة مثل مقاتلات الشبح F-35.
غير أن هذا التصور، بحسب المجلة، تغيّر جذريًا؛ إذ باتت الرياض ترى إيران أضعف بكثير مما كانت عليه، في حين ترى أن إسرائيل هي الطرف الذي يحمل طموحات هيمنة إقليمية. وهو ما دفع المملكة إلى إعادة توجيه سياساتها، عبر الابتعاد عن تل أبيب، وتحسين العلاقات مع طهران، خاصة في ظل رفض شعبي واسع لأي مسار تطبيع.
ووفقًا لـ"ناشيونال إنترست"، لم تقتصر التحولات السعودية على تحسين العلاقات مع إيران، بل شملت أيضًا تحركات للحد من النفوذ الإماراتي في اليمن والقرن الأفريقي، وتعزيز الشراكات مع تركيا وباكستان، في إطار إعادة رسم الخريطة الإقليمية بما يتوافق مع المصالح السعودية، وهو ما يعني تغييرًا في شكل وقواعد اللعبة الإقليمية.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نُشر في 11 يناير/كانون الثاني 2026، إلى أن تعثر مسار التطبيع مع السعودية تزامن مع تنامي المحور الإماراتي–الإسرائيلي، ومع الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد إيران.
وربط التقرير الإسرائيلي تراجع فرص التطبيع بسياق إقليمي أوسع، يتمثل في تفاقم التوتر بين الرياض وأبو ظبي، في وقت باتت فيه الإمارات تُعد الدولة العربية الأقرب فعليا إلى إسرائيل، وسط مخاوف سعودية من تموضع إسرائيلي متقدم في جوارها في حال انهيار النظام الإيراني وظهور سلطة موالية للغرب.
وذهبت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) إلى أبعد من ذلك، إذ نقلت عن مصادر وصفتها بـ"الخليجية المطلعة" أن محمد بن سلمان يعمل مؤخرًا على بلورة ما سمّته "محورا موازيا" لما يُعرف بـ"المحور السني المعتدل"، يضم دولًا مثل تركيا وإيران وقطر ومصر وباكستان.
وبحسب هذه المصادر، ينعكس هذا التوجه في تصعيد سعودي، علني وضمني، تجاه الإمارات، مع اتهامها بالعمل "بتنسيق مع إسرائيل" على نحو يتعارض مع المصالح السعودية، بل ووصف أبو ظبي بأنها "امتداد" أو "ذراع لإسرائيل" في المنطقة.
وأضاف التقرير أن الرياض باتت تنظر إلى إسرائيل بصفتها "المشكلة المركزية في الشرق الأوسط"، وهو ما يُفهم إسرائيليًا أيضًا كمحاولة سعودية لإعادة التموضع السياسي بما يسمح بتعزيز التقارب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتحدثت المصادر ذاتها عن مؤشرات وصفتها إسرائيل بـ"المقلقة"، من بينها تبنّي ولي العهد السعودي مقاربة أكثر مرونة تجاه جماعة "الإخوان المسلمين"، بالتوازي مع حماية مصالح تركية في الساحة الإفريقية.
وهو ما ذهبت إليه أيضًا صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير نشرته بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2026، تحت عنوان: "رهان محمد بن سلمان: السعودية تميل نحو تركيا وقطر، وتتجنب الكتلة الإسرائيلية–الأميركية".
وأكد التقرير أن محمد بن سلمان يعيد موازنة موقع المملكة الإقليمي بهدوء، عبر تخفيف مستوى التحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة، مقابل الاقتراب التدريجي من تركيا وقطر، بدل الانخراط في إطار "اتفاقيات أبراهام".
ولم يكن لافتًا مضمون التقرير فحسب، بل أيضًا هوية كاتبيه، إذ أعدّه كل من ليرون روز، وهو ضابط احتياط في استخبارات الجيش الإسرائيلي، وأميت شابي، محلل سابق في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، ما يعكس حجم القلق داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية من التحول الجاري في السياسة السعودية.