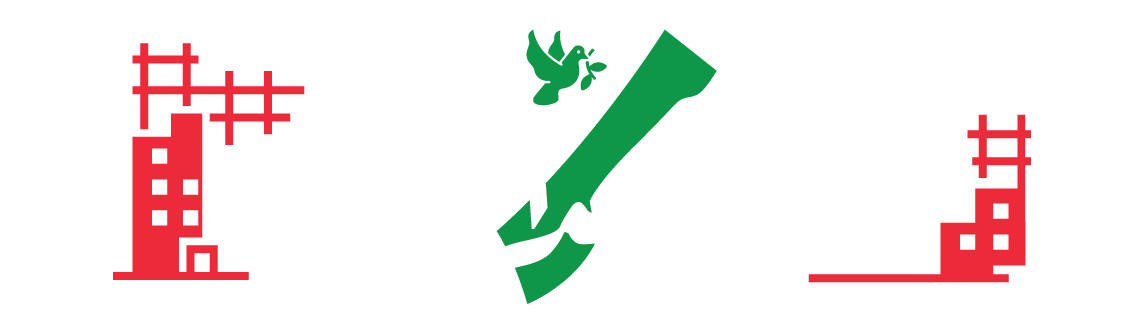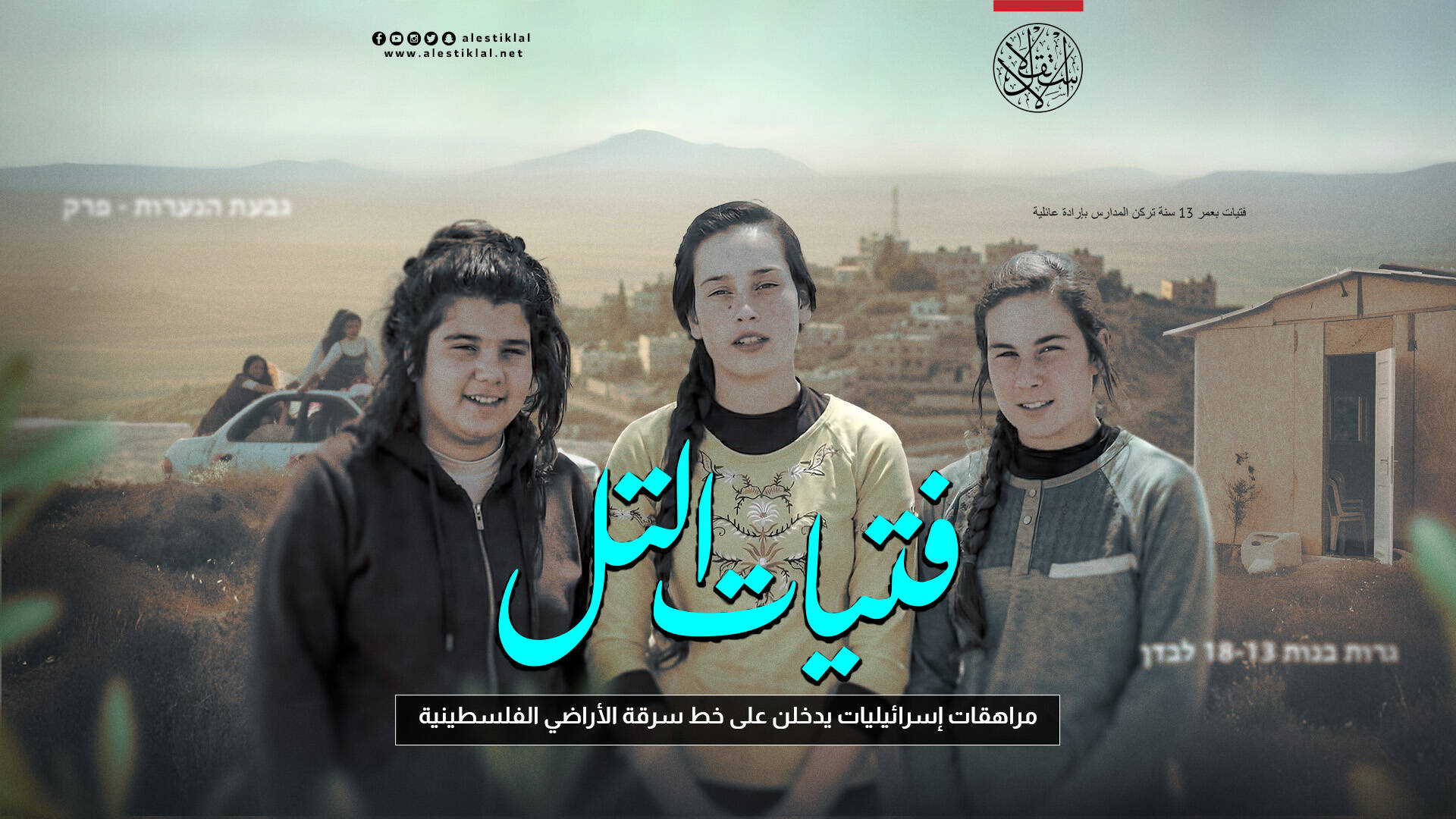الهند في مفترق الطرق.. هل أنهت التحالف مع الغرب وبدأت صفحة جديدة مع الصين؟

“ميزان القوى بين الصين والهند شهد تغيرات جذرية”
بعد أربع سنوات من التوتر، تحسنت بشكل مفاجئ العلاقات بين الهند والصين، وسط تساؤلات وتحليلات عن سر هذه التحولات الجيوسياسية الأخيرة.
وأشار موقع "ذا أوبسيرفر" الصيني إلى عدة عوامل محورية، منها تحسن العلاقات الصينية-الهندية وتراجع العلاقات الهندية-الأميركية، وفشل إستراتيجية "الفصل الاقتصادي" عن الصين.
وذكر الموقع أن الهند تتبع سياسة الثلاث لاءات مع الصين، "لا مواجهة مباشرة، لا حياد تاما، ولا تبعية للصين"، ما يعكس موقفها الحذر والمعقد في مواجهة النفوذ الصيني.
ورأى أن “الهند تحاول تحقيق توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، عبر اتباع سياسة براغماتية تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية”.
ذوبان الجليد
وسلط الموقع الضوء على أن العلاقات الصينية-الهندية شهدت تحولا بعد أكثر من أربع سنوات من "التجميد"، والسبب الأساسي يكمن في تعديل الهند لموقفها السياسي.
وأفاد بأنه "في ظل استقرار الموقف الصيني نسبيا، فإن تغيير موقف الهند أسهم بطبيعة الحال في تحسين العلاقات الثنائية".
وأوضح أن “أساس تحقيق هذا التصالح هو توصل الصين والهند إلى اتفاق بشأن قضية الحدود في القطاع الغربي، حيث يتضمن الاتفاق عدة جوانب رئيسة”.
ويتعلق الجانب الأول -بحسب الموقع- بمسألة دوريات الجيشين.
ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة، فإن الإطار العام يشير إلى أن الطرفين اعتمدا آلية دوريات مجدولة ومقسمة زمنيا.
وقبل عام 2020، كان نموذج الدوريات المتقاطعة هو المتبع على الحدود الصينية-الهندية.
ولكن بعد عام 2020، أصبحت مناطق السيطرة الفعلية لكل طرف مغلقة أمام الطرف الآخر، مما أدى إلى توقف الدوريات المتقاطعة، على حد قول الموقع.
وقد أعاد هذا الاتفاق إمكانية استئناف الدوريات للطرفين، مع تأجيل النقاش حول قضية السيادة على المناطق المتنازع عليها.
أما فيما يخص الجانب الثاني من الاتفاق، ذكر الموقع أن مشكلة الرعاة الحدوديين في المنطقة قد حُلت.
والجانب الثالث والأخير، يتمثل في أن هذه التفاهمات والاتفاقيات أسهمت في عقد لقاء بين قادة البلدين في مدينة قازان.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لم يكن في البداية يميل إلى حضور قمة قازان.
وجاء قراره بالمشاركة -بحسب الموقع- بناء على أمور إستراتيجية رئيسة.
الأمر الأول هو "الاستمرار في تحسين العلاقات بين الهند وروسيا، حيث قام مودي بزيارة موسكو سابقا، ثم زار أوكرانيا في خطوة متوازنة".
أما الأمر الثاني فهو يتمثل في "تعزيز تحسين العلاقات الصينية-الهندية".
جدير بالإشارة هنا إلى أن هذا التغير في الموقف ظهر بشكل ملموس منذ بداية عام 2024، حيث عقد وزيرا خارجية البلدين ثلاثة لقاءات.

خلافات إستراتيجية
وفي هذا السياق، أوضح "ذا أوبسيرفر" أن السبب الجوهري وراء "إعادة تشغيل" العلاقات الصينية-الهندية يكمن في التغيرات التي طرأت على العلاقات الهندية-الأميركية.
فبعد وصول إدارة جو بايدن إلى السلطة عام 2021، بلغت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة ذروتها، وهي الأعلى منذ استقلال الهند عام 1947، بحيث وُصفت بأنها تُماثل فترة الرئيس كينيدي.
علاوة على ذلك، رأى البعض أن الهند أصبحت حليفا للولايات المتحدة، لكن رغم ذلك، لم يستمر "شهر العسل" هذا -على حد وصف الموقع- طويلا.
وبحسب ما ذكره، فإن التناقض الرئيس كان يتمثل في أن إدارة بايدن، رغم حاجتها الإستراتيجية للهند لتحقيق التوازن واحتواء بكين، كانت تشعر بعدم ارتياح عميق تجاه حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة مودي من منظور أيديولوجي.
وبهذا الشأن، قال الموقع إن "هذا التناقض أدى إلى ظاهرة غريبة، وهي ازدهار العلاقات بين البلدين على السطح، لكن عدم قدرة القادة على بناء ثقة متبادلة".
فمن ناحية، كانت الولايات المتحدة تطور علاقاتها مع الهند، ومن ناحية أخرى، تحاول باستمرار تقليص نفوذ مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" داخل الهند.
وبدءا من عام 2023، زادت الولايات المتحدة من ضغوطها على حكومة مودي من خلال استهداف الشركات الكبرى التي يعتمد عليها حزب "بهاراتيا جاناتا" وخفض قيمة أسهمها.
وهذه التحركات -كما ورد عن الموقع- جعلت مودي يدرك أن "إدارة بايدن ليست الشريك المثالي، وبالتالي اختار التوصل إلى مصالحة مع الصين قبل إعلان نتائج الانتخابات الأميركية التي أنهت إدارة بايدن".

أزمة التصنيع
ومن أسباب تحسين العلاقات الصينية-الهندية أيضا، أشار "ذا أوبسيرفر" إلى أن "نيودلهي منذ عام 2020 بدأت بتنفيذ إستراتيجية (الفصل الاقتصادي) عن بكين، حيث اتخذت الأولى سلسلة من الإجراءات الصارمة".
ونتيجة لذلك، طُرد العديد من الشركات الصينية، كما حظرت الهند أكثر من 300 تطبيق صيني وقطعت الرحلات المباشرة بين البلدين، بل وأعادت الصحفيين الصينيين إلى بلادهم.
وفي هذه النقطة، نوه الموقع إلى أن "هذه التدابير كانت أكثر شدة وحزما من السياسات الأميركية تجاه الصين".
ولكن رغم ذلك، لفت إلى أن "نتائج هذه السياسات جاءت على عكس التوقعات".
فمن ناحية، لم ينخفض حجم التجارة بين الصين والهند، وإنما ارتفع بشكل ملحوظ.
ومن ناحية أخرى، بدأت السياسات المتشددة للفصل الاقتصادي في الإضرار بتطوير قطاع التصنيع الهندي نفسه.
ولذلك، دفع هذا الواقع صناع القرار في الهند إلى إعادة تقييم إستراتيجية "الفصل الاقتصادي" عن الصين.
وأدركوا تدريجيا أن صعود قطاع التصنيع الهندي لا يمكن أن يعتمد ببساطة على فك الارتباط مع الصين، بل يحتاج إلى الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتراكمة لديها على مدى فترة طويلة.
ولذلك، أوضح الموقع أن "هذا التغير في الفهم انعكس في تعديلات السياسات الأخيرة لحكومة مودي، حيث بدأت في انتهاج سياسة اقتصادية أكثر واقعية تجاه الصين".

سياسة اللاءات
وبشكل عام، ذكر الموقع أن "العلاقات الصينية-الهندية شهدت، على مدار العقد الماضي، تقلبات مستمرة مع محدودية واضحة في إمكانيات ومستوى التحسين".
وخلص إلى أن "تحسن العلاقات بين بكين ونيودلهي لا ينبع من رغبة قوية لدى الأخيرة، بل هو ناتج عن ضغوط خارجية وإخفاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، ما دفع الهند لاتخاذ خطوة إستراتيجية للتراجع المؤقت".
وعلى المدى المتوسط والطويل، توقع "ذا أوبسيرفر" أن تواصل الهند اتباع سياسة "الثلاث لاءات" في تعاملها مع بكين؛ لا مواجهة مباشرة، لا حياد تاما، ولا تبعية للصين.
وفيما يخص "لا" الأولى، أوضح الموقع أن ميزان القوى بين الصين والهند شهد تغيرات جذرية، إذ تعترف الهند بأنها تواجه "تحولا غير مسبوق في موازين القوى منذ قرن".
ولا سيما في المجال العسكري، حيث تبرز الفجوة بين البلدين، مما يجعل الهند تتجنب أن تكون في مقدمة المواجهة مع الصين.
أما بالنسبة لـ"لا" الثانية، ففي ظل المنافسة الإستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة، ترى الهند أن الوضع الحالي يشبه البيئة الدولية المواتية التي استفادت منها بكين خلال فترة إصلاحها وانفتاحها.
ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة الإستراتيجية النادرة، لا يمكن للهند أن تتخذ موقفا حياديا، حيث قد تفقد بذلك فرصة ذهبية لتحقيق التنمية.
وبالمجيء إلى "لا" الثالثة والأخيرة، أكد الموقع أنه مع تزايد نفوذ بكين في آسيا، وخاصة هيمنتها الاقتصادية، طرحت الهند مفهوم "آسيا متعددة الأقطاب"، بهدف موازنة الدور المهيمن للصين في شؤون المنطقة.