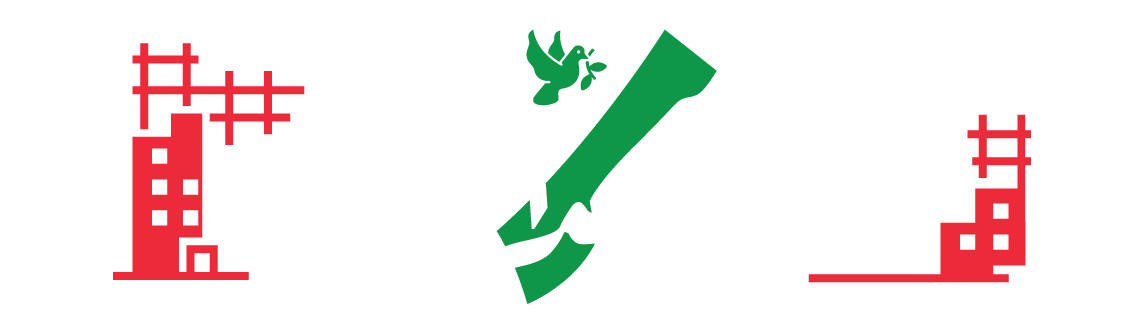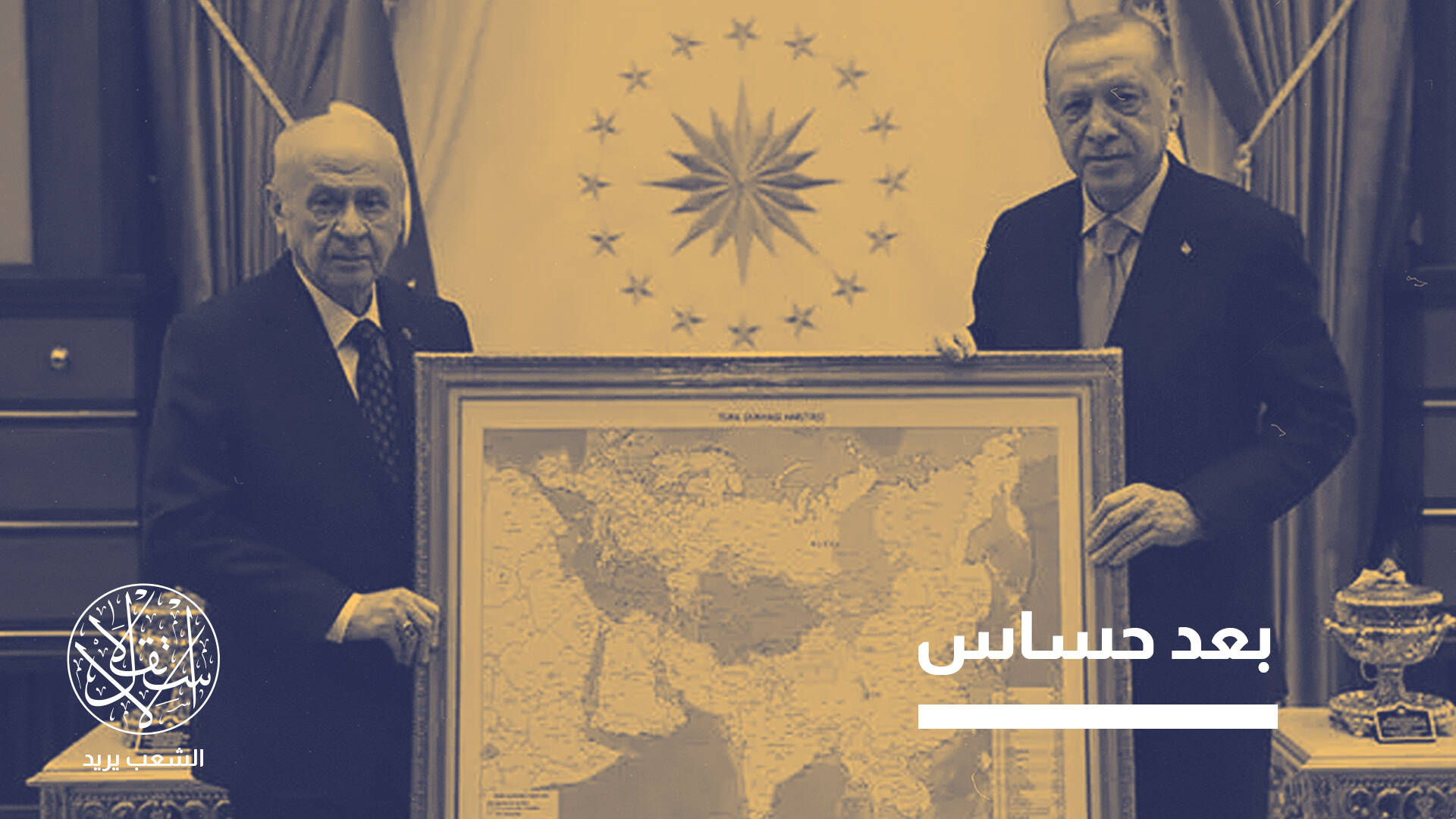"ممر خور عبد الله".. هل تحسم المحاكم الدولية الخلاف بين العراق والكويت؟

يُبرز الخلاف حول خور عبد الله تعقيدات ترسيم الحدود والمعاهدات في مرحلة ما بعد الصراعات
عاد "خور عبد الله" ليشكّل بؤرة توتر جديدة بين العراق والكويت. فبعد أن كان يُعتقد أن القضية حُسمت، أصبح الممر المائي محور نزاع حادٍّ حول السيادة، عقب إبطال المحكمة الاتحادية العليا العراقية معاهدة ثنائية وُقعت مع الكويت عام 2012.
يأتي هذا في وقت يسعى فيه العراق إلى إعادة بناء علاقاته مع جيرانه في الخليج، وإلى تنويع اقتصاده بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية، عبر تعزيز دوره في التجارة الدولية.
وتمتد جذور هذا الخلاف إلى تباين المطالب السيادية وتشابك المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، بما جذب أطرافا إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، ومراقبين دوليين يخشون من أن يشكّل النزاع سابقة خطيرة.
ويعكس الجدل أيضا صراعا داخليا في العراق بين من يرون الاتفاق انتقاصا من السيادة الوطنية، ومن يفضلون الحفاظ عليه.
في هذا السياق، نشر "المجلس الأطلسي" الأميركي مقالا للباحث القانوني رامي الخفاجي والمحامي الدولي صفوان الأمين، أكدا فيه على أن النزاع يمتد أثره ليشمل مسار التنمية الإقليمية.
"لا سيما مشروع ميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية في العراق، اللذين يهدفان إلى تحويل البلاد إلى مركز لوجستي يربط الخليج بأوروبا".
في المقابل، يُنظر في العراق إلى ميناء مبارك الكبير في الكويت -الذي يندرج ضمن رؤية الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق الصينية- على أنه يقيّد الوصول البحري ويهدد جدوى المشاريع العراقية، بينما يؤكد المسؤولون الكويتيون أنه يُعزز الترابط التجاري الإقليمي ولا يعيقه.
ويُبرز الخلاف حول خور عبد الله تعقيدات ترسيم الحدود والمعاهدات في مرحلة ما بعد الصراعات، وكيف يمكن أن تتحول القضايا القانونية التقنية إلى ملفات جيوسياسية واسعة.
وبالنظر إلى تشابك العوامل وتعقّد المشهد السياسي الداخلي، خصوصا في العراق، يبدو من الصعب التوصل إلى تسوية ثنائية لهذا النزاع، ما يفتح الباب أمام دور محتمل للهيئات القانونية الدولية كحكّام محايدين، بحسب المقال.

خلافات داخلية
ومن المهم الإشارة إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في عام 2023، الذي أبطل المعاهدة الثنائية، لم يستند إلى مضمون المعاهدة نفسها، بل إلى أسباب إجرائية بحتة.
إذ أكدت المحكمة أن الإلغاء جاء نتيجة مخالفات إجرائية، موضحةً أن هذه المخالفات جعلت المعاهدة باطلة منذ البداية، وبالتالي فإن العراق غير ملزم بها بموجب القانون الدولي.
ورأت المحكمة أن المصادقة على هذه الاتفاقية خالفت المادة 61 (الفقرة 4) من الدستور العراقي، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
فعند التصديق على الاتفاقية، كان القانون الصادر عام 1979 بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هو الساري، لكنه لم يتضمّن الشرط الدستوري الخاص بوجوب موافقة ثلثي البرلمان.
ونظرا لأن الدستور يسمو على القوانين العادية ويُعدّل ضمنيا أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه، فقد خلصت المحكمة العليا إلى أن قانون التصديق على معاهدة خور عبد الله، الذي أُقر بالأغلبية البسيطة، يُعدّ غير دستوري.
وبحسب المقال، يجد هذا الحكم سندا له في القانون الدولي، وتحديدا في المادة 46 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تجيز للدولة إبطال موافقتها على معاهدة إذا ثبت أن هذه الموافقة نُظمت في ظل انتهاك واضح لقوانينها الداخلية المتعلقة بسلطة إبرام المعاهدات.
مع ذلك، أثارت عدة عوامل تساؤلات حول هذا الحكم، بغضّ النظر عن وجاهته القانونية.
فعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة العليا خلال السنوات الأخيرة عددا من الأحكام المثيرة للجدل، وجرى النظر إليها بصفتها ذات دوافع سياسية، مع محدودية احترامها للمؤسسات السياسية الأخرى.
وقد أدت حدة هذه الخلافات إلى أزمة داخل المحكمة نفسها، انتهت أخيرا بتغيير في قيادتها.
كما أثار توقيت الحكم تساؤلات إضافية -وفق المقال- خصوصا أنه جاء بعد أن رفضت المحكمة ذاتها في عام 2014 قضية مماثلة كانت تطالب بإلغاء المعاهدة نفسها.
وشمل قرار المحكمة أيضا استعراضا تاريخيا للمنطقة ومطالبات بالسيادة عليها، وهو ما لم يكن ضروريا للفصل في مسألة إجرائية بحتة تتعلق بالقانون العراقي، وفق تقييم الخفاجي والأمين.
وترى بعض الدوائر داخل الحكومة العراقية أن الاتفاق الثنائي مع الكويت عام 2012 يمثل تنازلا عن السيادة، لأنه يمنح الكويت السيطرة على جزء كبير من المنفذ البحري العراقي. في المقابل، ترى الكويت أن الاتفاقية معاهدة دولية مشروعة وملزمة، وعلى العراق الالتزام بها.
وأضاف المقال: "أثار البعد السياسي وتوقيت قرار المحكمة العليا جدلا واسعا في أنحاء الخليج، فيما يرى مؤيدو القرار من العراقيين أنه تأكيد على الالتزام بالإجراءات الدستورية، في حين يرى منتقدوه أنه يعرقل جهود العراق لتعزيز تعاونه الإقليمي".

المبادئ القانونية
داخليا، أثار النزاع تعبئة سياسية واسعة؛ إذ قدّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد طلبين لإعادة النظر بهدف إلغاء حكم المحكمة الاتحادية العليا. ورأى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن الإلغاء يترتب عليه تبعات قانونية ودبلوماسية خطيرة.
وبعد جولات من النقاش الداخلي، دعا السوداني البرلمان إلى إعادة التصديق على المعاهدة، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ عليها لأسباب دبلوماسية.
في المقابل، وقع نحو 200 نائب عريضة تطالب بإلغاء اتفاقية البحرية عام 2012 البحرية بشكل رسمي، ويرون أنها اتفاقية "مذلّة" تمس السيادة الوطنية، وجاءت نتيجة استغلال ضعف موقف العراق الدولي عقب حرب الخليج عام 1991.
بدورها، تؤكد الكويت أن اتفاق عام 2012 مع العراق يُعد معاهدة دولية صحيحة وملزمة، وقد جرى تسجيلها لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاقها.
وتشير الكويت إلى أن الاتفاق مثّل تتويجا لجهود تطبيع العلاقات بعد حرب الخليج عام 1991، واستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي رسم الحدود البرية بين البلدين.
كذلك، يرى المسؤولون الكويتيون أن اعتراضات العراق اللاحقة ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى الأساس القانوني، متهمين بغداد بمحاولة "إعادة كتابة التاريخ" بعد عقود من إبرام الاتفاق.
وصرّح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح بأن حكم المحكمة الاتحادية العراقية تضمّن "مغالطات تاريخية".
وأفاد المقال بأن الأساس القانوني لنزاع خور عبد الله يرتكز على مزيج من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، إضافة إلى القانون الدولي للبحار.
وبموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تنص المادة 26 على وجوب التزام الدول بالمعاهدات التي أُبرمت بصورة صحيحة. وتستند الكويت إلى هذه المادة، مؤكدة أن اتفاق عام 2012 قد سُجّل لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاقها.
ومع ذلك، تتيح المادة 46 من الاتفاقية لأي دولة الطعن في صحة موافقتها إذا كانت نتيجة انتهاك واضح لقوانينها الداخلية المتعلقة بصلاحيات إبرام المعاهدات.
ويشمل النزاع أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، إذ تنظم المواد 15 و74 و83 منها قضايا ترسيم الحدود البحرية وضمان الوصول العادل، في حين تكفل المواد 17 إلى 19 حق المرور البريء في الممرات المائية.
كما ينص الجزء الخامس عشر (المادة 287) على آليات تسوية النزاعات عبر المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) أو محكمة العدل الدولية، أو التحكيم الدولي.
وتستند القضية أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي حدّد الحدود البرية بين العراق والكويت، وميثاق الحقوق الاقتصادية وواجبات الدول (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3281 لعام 1974، المادة 9) الذي يحظر الأنشطة التي تسبب أضرارا اقتصادية في المناطق المشتركة.
وتحدد هذه الأدوات مجتمعة الإطار القانوني الذي يُنظّم أبعاد النزاع الحالي.
مستقبل النزاع
وقال الكاتبان: "إذا رفض البرلمان العراقي تصديق الاتفاق، فإنه يجب التوصل إلى حل دائم وفاعل يقوم على إعادة الانخراط والتعاون بين الطرفين، ويستند إلى العدالة والمصلحة الاقتصادية المشتركة، مع احترام كل من القانون الدولي والدستور العراقي".
"وفي حال قررت بغداد والكويت حل نزاعهما عبر محكمة العدل الدولية، فإن قضية ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين تمثل سابقة مهمة لحل النزاعات البحرية في منطقة الخليج بشكل سلمي"، وفق المقال.
"وبصفتها القضية الوحيدة المتعلقة بالحدود البحرية بين الدول العربية أمام المحكمة الدولية، تبيّن أن النزاعات الطويلة الأمد في الخليج يمكن تسويتها عبر التحكيم الدولي والسلطة القضائية الدولية".
كما قد تكون "المحكمة الدولية لقانون البحار" (ITLOS) منتدى مناسبا أيضا لحل النزاع، بالنظر إلى اختصاصها المتخصص وخبرتها في قضايا الحدود البحرية وحرية الملاحة، بحسب الكاتبين.
وأضاف المقال: "في النهاية، يُعد نزاع خور عبد الله أكثر من مجرد خلاف تقني حول الحدود البحرية".
وختم بأنه "من خلال اختيار الحوار واللجوء إلى التحكيم القانوني، يمكن للعراق والكويت تحويل هذا النزاع المحتدم إلى رمز للدبلوماسية الإقليمية والنظام القانوني الدولي، مع إظهار الاحترام والالتزام بالقانون الدولي والهيئات القضائية الدولية".