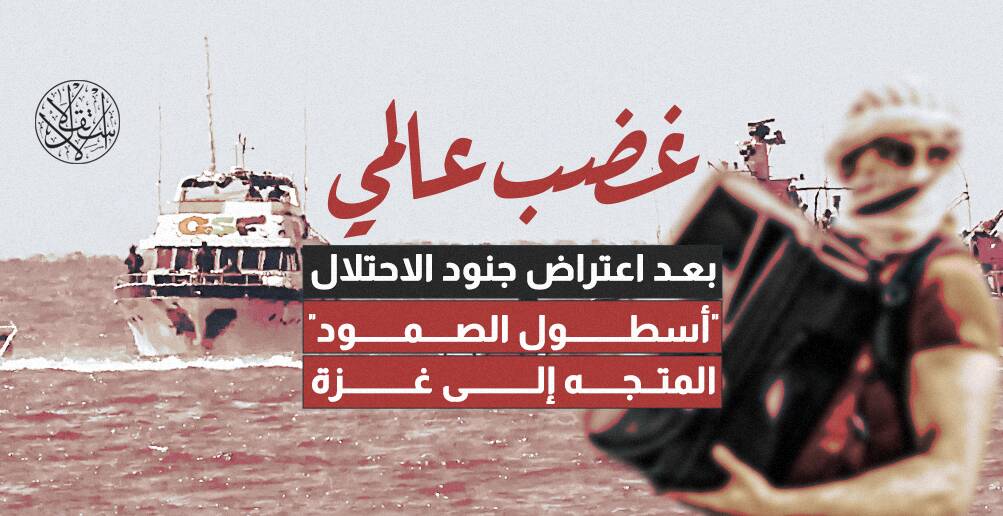النفوذ التركي في غرب البلقان.. كيف أثر على الحضور السعودي؟

تركيا ترى نفسها وريثة للدولة العثمانية في غرب البلقان
برزت تركيا خلال السنوات الأخيرة، كفاعل طموح في منطقة غرب البلقان، مسخرة أدوات القوة الناعمة لترسيخ نفوذها، وعلى رأسها الدين والعمارة ذات الطابع العثماني.
ومن خلال مشاريع ضخمة كمسجد "نمازغاه"، في العاصمة الألبانية تيرانا، وسلسلة مبادرات دينية وثقافية، تسعى أنقرة إلى تقديم نفسها كقوة إقليمية ذات ميراث حضاري بديل للغرب، وفق ما يقول موقع "دويتشه فيله" الألماني.
وأردف: "لا ينفصل هذا التوجه عن تحولات أوسع في السياسة الخارجية التركية، التي باتت تعتمد على ما يمكن وصفه بإمبريالية البنية التحتية".
وبحسب الموقع، يأتي هذا في وقت تشهد فيه القوى المنافسة، وعلى رأسها السعودية، تراجعا عن أدوارها التقليدية في نشر النفوذ الديني.
وهذا الحراك التركي يعكس تداخل الدين بالسياسة واستخدام الرموز الدينية كوسائل لإعادة إنتاج شرعية جديدة تعزز حضور أنقرة في محيطها الجغرافي والتاريخي. وفق تقديره.

مشروع سياسي ديني
ويعد مسجد “نمازغاه” من أبرز المعالم الدينية الإسلامية في غرب البلقان؛ حيث يتميز بمآذن يبلغ ارتفاعها 50 مترا وسعة تستوعب نحو 8000 مصلٍّ.
ومول بناء هذا المسجد جزئيا من قبل هيئة الشؤون الدينية التركية، بتكلفة تُقدر بحوالي 30 مليون يورو.
استُوحي تصميمه المعماري من مسجد السلطان أحمد الشهير في إسطنبول، في إشارة رمزية للهوية العثمانية التي تسعى تركيا لإحيائها في المنطقة.
وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تيرانا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، للمشاركة في افتتاح المسجد، بعد حوالي 10 سنوات من بداية أعمال البناء.
وخلال هذه الزيارة، وقع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الألبانية في مجالي الزراعة والتعليم، كما قدم عددا من الطائرات المسيرة التركية هدية للدولة.
علاوة على ذلك، يقول الموقع: إن “نفوذ هيئة الشؤون الدينية التركية ثُبت ضمن مجلس إدارة المسجد الجديد، إلى جانب تعيين إمام تركي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واستياء داخل بعض الأوساط الألبانية”.
وتاريخيا، جاءت هذه الخطوة بعد تحولات دينية كبيرة في ألبانيا، فبعد انهيار النظام الشيوعي عام 1990، شهدت العاصمة بناء كاتدرائيتين بارزتين؛ واحدة كاثوليكية افتُتحت عام 2001، وأخرى أرثوذكسية افتُتحت عام 2014.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ألبانيا، في عهد أنور خوجة (حكم البلاد بالحديد والنار 40 عاما من 1944 إلى 1985)، كانت قد أعلنت نفسها أول دولة ملحدة في العالم؛ حيث حُظرت الأديان منذ عام 1967، وأُغلقت جميع المؤسسات الدينية.
وفي هذا السياق، توضح الباحثة في العلوم الاجتماعية ناتالي كلايير، من مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس "EHESS"، أن "مسجد “نمازغاه”، نموذج يبين كيف تعمل تركيا على توسيع نفوذها في غرب البلقان بصفتها قوة إقليمية، من خلال استخدام بناء المساجد كأداة للنفوذ".
وتضيف الخبيرة أن "المساجد كأداة للقوة الناعمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية". وأشارت إلى أن "الجهات المحلية تملك هامشا من المناورة، وغالبا ما تستفيد منه بما يتماشى مع أولوياتها".
ومن جانب آخر، يبرز "دويتشه فيله" أن هذا المشروع يظهر جانبا آخر من الضغوط السياسية التركية؛ إذ توقفت أعمال بناء المسجد بين عامي 2017 و2019، بعد أن طالبت أنقرة تيرانا بتسليم عدد من الأفراد المشتبه بانتمائهم إلى جماعة فتح الله غولن.
فقد حمل أردوغان المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، لتلك الجماعة التي كان يقودها الداعية المتوفي فتح الله غولن، وبدأ بملاحقة أتباعها داخل تركيا وخارجها. وبحسب ما ورد عن الموقع لم تُستأنف أعمال البناء إلا بعد تنفيذ عمليات التسليم المطلوبة.
وفي هذا الصدد، تلخص المشهد قائلة: إن “هذا المشروع لا يقتصر على بعده الديني أو المعماري، بل يجسد تقاطع الدين بالسياسة، والرمزية بالإستراتيجية، في سياق صراع النفوذ المتصاعد في منطقة البلقان”.

تركيا في الصدارة
وفي هذا الإطار، يشير الموقع إلى أنه "رغم أن العديد من مشاريع بناء المساجد تُمول عبر مساعدات خارجية، فإن المبادرة غالبا ما تنطلق من المجتمعات المحلية ذاتها".
ومع ذلك، توضح الباحثة ناتالي كلايير أن "الأمور تختلف في حالة الأبنية الدينية الرمزية، لا سيما في العواصم، حيث تتداخل مصالح الفاعلين المحليين والدوليين على حد سواء".
وتشرح ذلك قائلة: "هيبة الدولة واحتياجات المجتمع الإسلامي وتأكيد الهوية الوطنية والمواقف تجاه الأديان الأخرى كلها عوامل تساهم في قرار بناء دور العبادة، وكذلك في اختيار الطرازات المعمارية".
ويقول الموقع الألماني: إن "تركيا ترى نفسها وريثة للإمبراطورية العثمانية في غرب البلقان، وتؤكد على طموحها كقوة إقليمية".
إلا أن الأمر لا يقتصر على السياسة الدينية لحكومة حزب "العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان، كما يقول الموقع.
بل يُعد بناء المساجد مجرد عنصر واحد ضمن سياسة بنية تحتية تركية شاملة، ليس في غرب البلقان فقط، بل أيضا في القوقاز وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وهنا، تشير ريبيكا براينت، أستاذة الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة أوتريخت إلى "ضرورة فهم بناء المساجد في سياق جيوسياسي أوسع".
وتوضح براينت أن "الأفق المعماري المستقبلي في أستانا -على سبيل المثال- أُنجز بشكل كبير على يد شركات بناء تركية، وأن كثيرا من المناقصات تُمنح لشركات مقربة من أردوغان".
وتصف براينت هذا النوع من التأثير السياسي بمصطلح "إمبريالية البنية التحتية".
وفي هذا السياق، يضيف الموقع أن المجمع الذي افتتحه أردوغان في مايو/ أيار 2025 بعد خمس سنوات من البناء في قبرص الشمالية يعد من بين المشاريع العملاقة. فهذا المجمع يضم قصرا رئاسيا ومبنى برلمانيا وفنادق كبيرة ومسجدا.
ومن وجهة نظر براينت، تُعد هذه المشاريع "أماكن جيوسياسية تُجسد فيها تركيا تصوراتها للمستقبل".
وفي هذه النقطة، يبرز "دويتشه فيله" أن "أردوغان يعتمد في هذه الإستراتيجية على الروابط العرقية والدينية والتاريخية، مستخدما خطابا يستند على الأخوة والمصير المشترك الذي يربط تركيا بتلك الدول".
وتهدف هذه المشاريع إلى إيصال رسالة مفادها: "نحن المستقبل، وأكثر حداثة من الغرب". وتابع قائلا: "وهكذا، يُعد بناء المساجد جزءا من رؤية تركية للمستقبل؛ حيث لم يعد الغرب هو النموذج النهائي للتقدم".

السعودية تتراجع
وبالحديث عن القوى الأخرى، أردفت ناتالي كلايير أن "تركيا أصبحت اليوم اللاعب الرئيس في تمويل بناء المساجد بمنطقة غرب البلقان"، منوهة إلى أن "هذا الدور لم يكن لها في البدايات".
فخلال حرب البوسنة (1992–1995)، دُمر حوالي 600 مسجد بالكامل، وتعرض المئات لأضرار متفاوتة، بحسب ما يذكره الباحث روبن كونييه في دراسته حول بناء المساجد في البوسنة والهرسك.
وعقب انتهاء الحرب في عام 1995، تلفت الصحيفة إلى أن "السعودية كانت هي الممول الأساسي لإعادة إعمار المساجد، خاصة عبر نشر نموذجها الديني الوهابي".
ولكن بدأ هذا المشهد -بحسب الموقع- يتغير بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ومع صعود رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2002.
"إذ بدأت أنقرة تتقدم بثبات نحو الصدارة في هذا المجال، مستبدلة النفوذ السعودي بآخر عثماني الطابع، يجمع بين البعد الديني والمشروع السياسي".
وبتسليط الضوء أكثر على السعودية، يقول "دويتشه فيله": إنها "تراجعت تدريجيا عن نشاطها في هذا المجال تحت قيادة الحاكم الفعلي، ولي العهد محمد بن سلمان".
ويوضح أن مشاريع بناء المساجد الممولة سعوديا سُلمت إلى جهات محلية.
وفي إطار "رؤية 2030"، التي تحدد أولويات السياسة السعودية حتى نهاية هذا العقد، أعطى ابن سلمان الأولوية لترميم المساجد التاريخية داخل المملكة للحفاظ على الإرث الثقافي المحلي.
وفي هذا الشأن، تقول كريستين سميث ديوان، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة: "إن القومية السعودية أصبحت محور الاهتمام اليوم بدلا من الإسلام الوهابي".
وهنا، يؤكد الموقع أن "ابن سلمان تخلى، على الأقل رسميا، عن الإسلام الوهابي الذي كانت السعودية تصدره لسنوات طويلة".