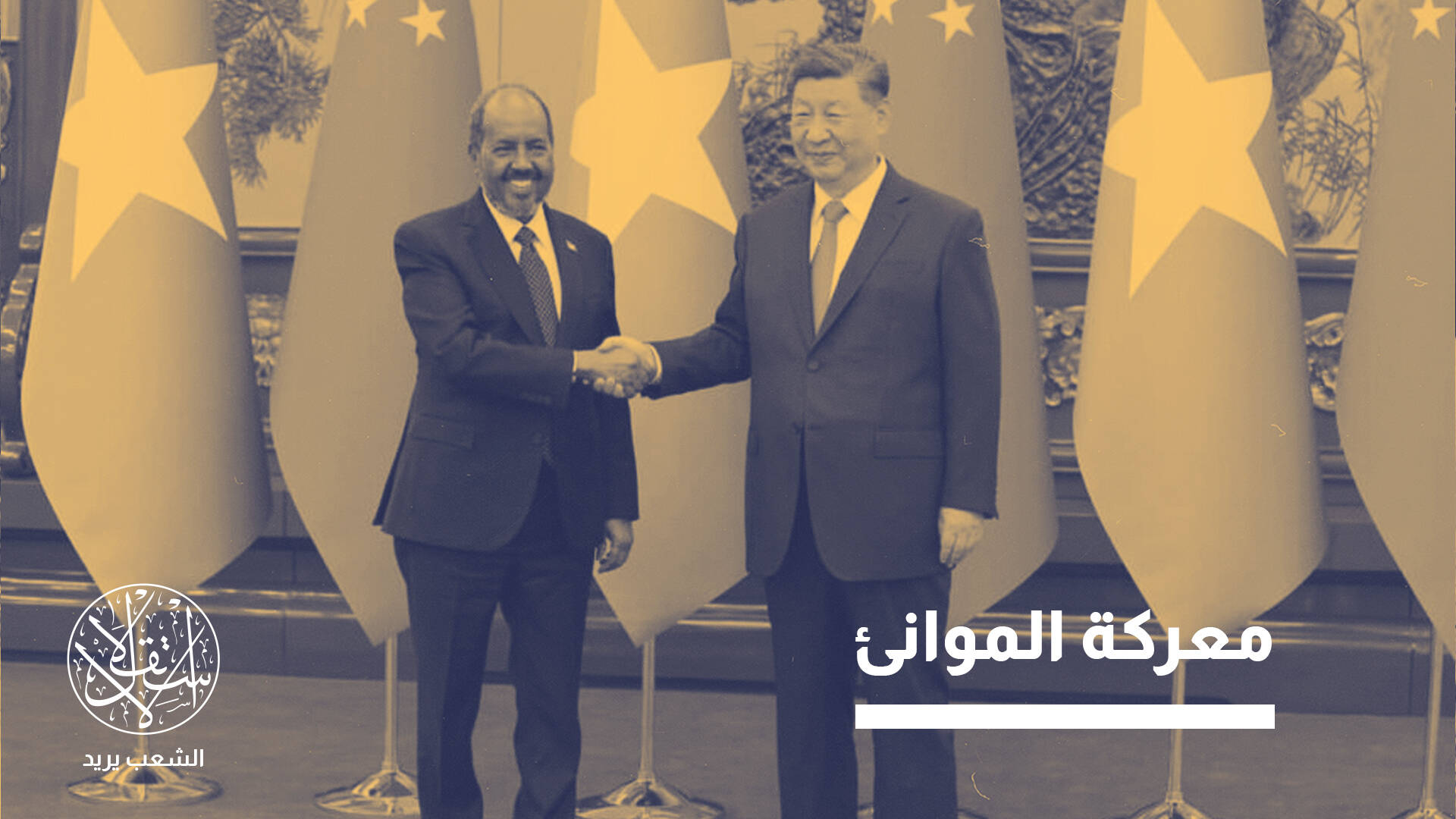الاقتصاد.. معركة بلا رصاص تهدد نظام الأسد في سوريا

معركة أخرى تدور في سوريا، لا تنفصل عن تلك التي تخوضها جيوش ومليشيات دولية وإقليمية منذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس/آذار 2011، لكنها ترتبط بها بشدة، بل تعد من أبرز انعكاساتها، وهي الحرب الاقتصادية، أو ما يقال عنها "اقتصاد الحرب".
وكما للحرب العسكرية ضحايا، فإن حرب الاقتصاد لا تقل ضراوة ويدفع ثمنها أيضا البسطاء الذين يشكلون الغالبية العظمى من السوريين، فيما تنشط بقوة طبقة أخرى تقتات من استمرار الحرب وتحقق مصالحها فيها.
فما ملامح تلك الحرب، وكيف تمكن نظام بشار الأسد من الاستمرار اقتصاديا وماليا طيلة الأعوام الماضية، وبأي أدوات يخوض حربه، وإلى أي مدى تؤثر الحرب على السوريين؟
اقتصاد الحرب
لاشك أن الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من 8 سنوات ألقت بظلال وخيمة على اقتصاد البلاد، لينتقل، عاما بعد عام، من سيئ إلى أسوأ على كافة المستويات وبسرعة قياسية.
ولمعرفة حجم هذه النقلة السلبية، يجب التعرض أولا لوضع الاقتصاد السوري قبل 2011، فعلى مدار 10 سنوات أقر نظام الأسد خطتين خمسيتين لفتح باب الاستثمار وإجراء ما يسمى "إصلاح اقتصادي" يعتمد على زيادة الضرائب وخفض الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية الأساسية وخصخصة القطاع العام.
وبالفعل تحسنت المؤشرات كثيرا، فبلغ الناتج المحلي 60 مليار دولار عام 2010، ووصل متوسط معدل النمو إلى 5 بالمئة، وتم التخلص من الديون الخارجية بشكل شبه نهائي بعدما تنازلت الدول الدائنة (أغلبها من دول الاتحاد السوفييتي السابق) عن جزء كبير من مستحقاتها، ووصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 20.6 مليار دولار، واستقر متوسط سعر الصرف عند مستوى 50 ليرة مقابل كل دولار.
ورغم جودة الأرقام، إلا أنها لم تنعكس على حياة المواطنين، فنسب البطالة كانت لا تزال مرتفعة للغاية، كما أن ثمار هذا الإصلاح كانت تذهب إلى رجال النظام ورجال الأعمال من عائلة الأسد والعائلات المقربة منها مثل: مخلوف وشاليش والأخرس، بحسب تقارير إعلامية.
واستمر معدل التضخم في الارتفاع، حتى وصل في عام 2008 إلى 15بالمئة، نتيجة إجراءات رفع الدعم عن السلع الرئيسية، وكان الفساد ينخر جسد الدولة، واحتلت سوريا المركز 137 من أصل 181 دولة في مؤشر ممارسة الأعمال عام 2009، فيما كانت نسبة الفقراء عند الحد الأعلى للفقر 33.6 بالمئة من السكان.
ومع هذا الوضع تمكن السوريون من التأقلم، غير أنه ومنذ انطلاق الحرب تغيرت الأحوال إلى الأسوأ، فوفق الأرقام التي أعلنتها سلطات النظام وصل فيها الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2016 إلى 11.9 مليار دولار بانخفاض قدره 80 بالمئة عما كان عليه عام 2010. وتراجعت الليرة السورية بشكل حاد مقابل الدولار، حتى أصبح 1 دولار = 500 ليرة، وأصبحت تمثل 9 بالمئة فقط من قيمتها قبل اندلاع الحرب.
ووصلت معدلات البطالة في سوريا إلى 50 بالمئة، ويعيش نحو 80 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة الآمنين غذائيا عام 2017 إلى 23 بالمئة فقط، مقابل 31 بالمئة من السكان غير آمنين غذائيا، وأكثر من 45 بالمئة في منطقة الخطر.
الاحتياطي من النقد الأجنبي هوى حتى عام 2016 إلى 700 مليون دولار فقط، أي أقل من 4 بالمئة فقط من حجمه عام 2010، وبلغت الديون الخارجية حتى عام 2019 نحو 4.6 مليار دولار، تمثل نحو 39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما مثلت الديون الداخلية عام 2017 نحو 95 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتقدر تكاليف عملية إعادة إعمار سوريا وبنيتها التحتية التي خربت بنحو 400 مليار دولار.
معركة الجباية
في ميدان آخر يخوض نظام الأسد حربا ضروسا ليس بطبيعة الحال لتحسين معيشة الشعب أو وقف نزيف الخسائر، بل لضمان استمراره وشراء ولاء المجموعات المؤثرة المحيطة به.
وبحسب دراسة أعدها المرصد الإستراتيجي: فإن الحيلة التي اتبعها النظام لإنقاذ الليرة السورية، تمثلت في ضخ رجال الأعمال أموالا لمنع انهيارها، وذلك خلال اجتماع جرى في فندق الشيراتون بدمشق، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، جمع من يطلق عليهم "أثرياء الحرب"، وهي الطبقة الموالية التي كونت ثروات كبيرة جراء دعم النظام لها مع حاكم المصرف المركزي.
ودار الحديث عن جمع نحو 150 مليون دولار من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام مثل: رامي مخلوف وإخوته، ومحمد حمشو وشقيق زوجته، وسامر الفوز، وبراء وحسام قاطرجي، ووسيم قطان، ونبيل طعمة، ومحمد سواح، بالإضافة إلى تجميد حسابات ومنع تسهيلات لآخرين عقابا على رفضهم التماهي مع حيلة النظام.
وبلغت قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية منذ بداية العام الجاري 584 حجزا شملت نحو 10315 شخصا، ووفقا لمصادر محلية: فإن حاكم المصرف المركزي، حازم قرفول، قرأ في اجتماعه مع رجال الأعمال قائمة بممتلكات بعضهم قبل عام 2011 وبعده، وما حصلوا عليه من مزايا والصفقات المشبوهة التي أنجزوها للتأكيد على أن ملفاتهم جاهزة لتفتح في أية لحظة.
هذا الضغط على رجال الأعمال لسحب إيداعاتهم بالدولار من البنوك اللبنانية وإيداعها في البنوك السورية أسفر عن أزمة في وفرة النقد الأجنبي بلبنان، وكشفت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية: عن قيام "شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى مقربة من النظام السوري، بعمليات غير سليمة، وسحب عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي الموزعة في الشوارع، من أجل تحويلها إلى سوريا".
وفي خطوة يائسة أخرى، أقرت حكومة النظام نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض الإيرادات العامة إلا أن ذلك التخفيض لم يشمل الرسوم والضرائب الجمركية التي ارتفعت بنسبة 44.12 بالمئة مقارنة بعام 2019، وكان رئيس الوزراء، عماد خميس، كشف عن انخفاض موجودات المصرف المركزي السوري، وتراجع إنتاج النفط اليومي من 380 ألف برميل إلى صفر برميل، وأن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا.
كما تحدث عن تأثر السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب، بحيث أصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، وكذلك الحال بالنسبة لخطوط النقل وباقي البنى التحتية.
في هذه الأثناء؛ تتعالى استغاثات السوريين من تفاقم موجة غلاء الأسعار، وتسود حالة من التشاؤم بعد أن دفع انحدار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى موجة انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها وتطالبها بوضع حد لحالة الانهيار الاقتصادي.
ثورة ثانية؟
هذا الواقع المأساوي دفع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى التساؤل عن إمكانية قيام ثورة ثانية ضد نظام بشار الأسد، مع تعبير السوريين الذين ظلوا موالين للأسد طوال سنوات الحرب عن استيائهم المتزايد لاستمرار تدهور مستويات المعيشة في البلاد حتى مع انتهاء الصراع.
وقالت: إنه "ولأول مرة، يعيش أولئك الذين يسكنون في المناطق الموالية للحكومة التي تجنبت أسوأ أعمال العنف، بعضا من أقسى أشكال الحرمان، بما في ذلك في العاصمة دمشق".
ونقلت عن كاتب مقيم في دمشق، رفض الكشف عن هويته، قوله: إن غزو ضاحية الغوطة الشرقية العام الماضي أنهى إطلاق الصواريخ، لكنه لم يجلب راحة السكان الذين كانوا يأملون في ذلك. وأضاف: "هذا هو أسوأ ما عرفناه على الإطلاق. بالكاد يستطيع الناس البقاء على قيد الحياة".
وتابع التحقيق المطول: أن تعهدات الحكومة بتدفق أموال المستثمرين العرب إلى دمشق، والتمويل الصيني لإعادة الإعمار، لم تتحقق وسبب ذلك خيبة أمل لدى السوريين، وسط ترجيحات بأنه لن يتم الوفاء بها على المستوى المنظور.
وقال داني مكي، المحلل والصحفي البريطاني المقيم في دمشق: "ما يوصف بأنه انتصار عسكري كبير لم يترجم إلى تحسين نوعية الحياة التي كانت متوقعة. لديك 3 إلى 4 بالمئة من الناس الذين لديهم الغالبية العظمى من الثروة، وبالنسبة للباقي فالحياة مجرد صراع".
تنعكس هذه التعاسة، وفق الصحيفة: على سيل غير مسبوق من الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي يطلقها الموالون للأسد، بما في ذلك بعض المشاهير والشخصيات التلفزيونية الذين استخدموا مكانتهم في الماضي لحشد الدعم لنظامه.
وحول هؤلاء قالت: إنه "لم يعد هناك شعور بأنهم بحاجة إلى التماسك في مواجهة عدو مشترك. الناس يقولون: لقد هزمنا العدو المشترك، لذلك دعونا الآن ننظر إلى من المسؤول عن الكارثة التي نحن فيها".
ورغم أن الصحيفة استبعدت اندلاع ثورة ثانية في ظل هذه الظروف، إلا أنها أثارت أسئلة حول الاتجاه المستقبلي لسوريا واستدامة حكم القبضة الحديدية لعائلة الأسد.
صمود الأسد
ويبقى تساؤل بالغ الأهمية في سياق الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب في سوريا، وهو كيف استطاع نظام الأسد البقاء وسط هذه الأزمة، ومن أين كان يحصل على التدفقات المالية التي مكنته من ذلك؟.
"التحايل على الاقتصاد النظامي وتدميره، ونمو الأسواق غير النظامية والسوداء، وسيادة السلب، والابتزاز، السيطرة على الأصول المربحة بالقوة المسلحة، استغلال اليد العاملة، الاعتماد على التهريب".. تلك كانت بعض المقومات التي يقوم عليها اقتصاد الحرب.
وبحسب دراسة لمركز "كارنيجي" للشرق الأوسط: فإن عجلة الاقتصاد لا تتوقف تحت أي ظرف، وأن النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد يستعد دائما لاندلاع الحرب، سواء داخلية أو خارجية.
الدراسة أفادت: بأن نفقات الدفاع في سوريا كانت تصل في أوقات توقف المعارك إلى أكثر من 12 بالمئة من مجمل الموازنة العامة للدولة، وتصل في حالة اندلاع المعارك أو في حالة التعبئة العامة إلى أكثر من 25 بالمئة، ولأن النظام خاض العديد من الحروب مع إسرائيل وفي لبنان، فقد كان مستعدا بشكل ما لمثل هذه الظروف غير العادية.
محاولات البقاء التي خاضها نظام بشار الأسد، ترجمتها قرارات اقتصادية عدة، بدأت بخفض الموازنة العامة، والنفقات الاستثمارية، واتجهت إلى تفاصيل دقيقة في توفير واقتصاد النفقات، منها خفض استخدام السيارات الحكومية وتقليص حصتها الشهرية من الوقود، وصولا إلى حملات إعلامية لترشيد الطاقة، وحتى ترشيد استخدام الورق في المؤسسات الحكومية.
كما لجأ النظام إلى الاستدانة بشكل ضخم من الداخل، حتى وصلت الديون الداخلية نهاية عام 2014، إلى نحو 3400 مليار ليرة، أي ما يعادل 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وذلك بعد أن كانت الديون الداخلية قبل الأزمة 320 مليار ليرة فقط.واستنزف النظام الاحتياطي النقدي السوري حتى تقلص من نحو 20 مليار دولار عام 2010 إلى 700 مليون دولار فقط عام 2016، وانتقل للبحث عن موارد جديدة ومن ذلك ما كشفته صحيفة "الجارديان" البريطانية في 2013.
الصحيفة قالت: إن نظام الأسد يشتري النفط أو يمرره عبر اتفاق مالي مع "جبهة النصرة" التي كانت تسيطر في ذلك الحين على مناطق واسعة شمالي وشرقي سوريا، وأصبحت المعابر بين مناطق النظام والمعارضة والمعابر الخارجية أحد أهم مصادر تمويل النظام.
وأضافت: أنه مع توجيه فصائل المعارضة المسلحة أسلحتها على بعضها البعض في المعركة على النفط والمياه والأراضي الزراعية، تراجعت الضغوط العسكرية على حكومة بشار الأسد من الشمال والشرق، وفي بعض المناطق، أبرمت "النصرة" صفقات مع القوات الحكومية للسماح بنقل الخام عبر الخطوط الأمامية إلى ساحل البحر المتوسط.
فضلا عن ذلك، اتجه النظام إلى الاستدانة من الخارج، فحسب تقرير للبنك الدولي: بلغت الديون الخارجية للنظام السوري حتى العام الجاري 4.6 مليار دولار، وقدمت إيران للنظام عشرات مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة، سواء بشكل مباشر، أو على هيئة سلع وبضائع، أو في شكل أسلحة ومعدات حربية.ووفق تقديرات الأمم المتحدة عام 2018: فإن متوسط إنفاق إيران في سوريا يعادل 6 مليارات دولار سنويا، ما يعني أن نحو 36 مليار دولار، ساهمت بشكل مؤثر وفعال في بقاء الأسد بمنصبه.
كما قدمت روسيا مليارات الدولارات لنظام الأسد، سواء عبر القروض والمساعدات المعلنة والخفية، أو عبر الدعم العسكري بشقيه المباشر وغير المباشر، ووفق تقرير لـ"الواشنطن بوست": فإن موسكو تنفق 1.8 مليار دولار سنويا على مقاولين عسكريين في سوريا، منذ بداية تدخلها المباشر في الصراع عام 2015.
المصادر
- الناتج المحلي السوري يفقد 80% من قيمته خلال 7 سنوات
- سلطة بشار الأسد تتداعى
- Assad loyalists are turning on Syria’s government as living standards deteriorate
- عجلة الاقتصاد لا توقفها الحرب: هكذا صمد نظام بشار الأسد
- اقتصاد الحرب في الصراع السوري: تكتيك "دَبِّر راسك"
- EU decision to lift Syrian oil sanctions boosts jihadist groups
- الحرب السورية: نزيف إيران المستمر