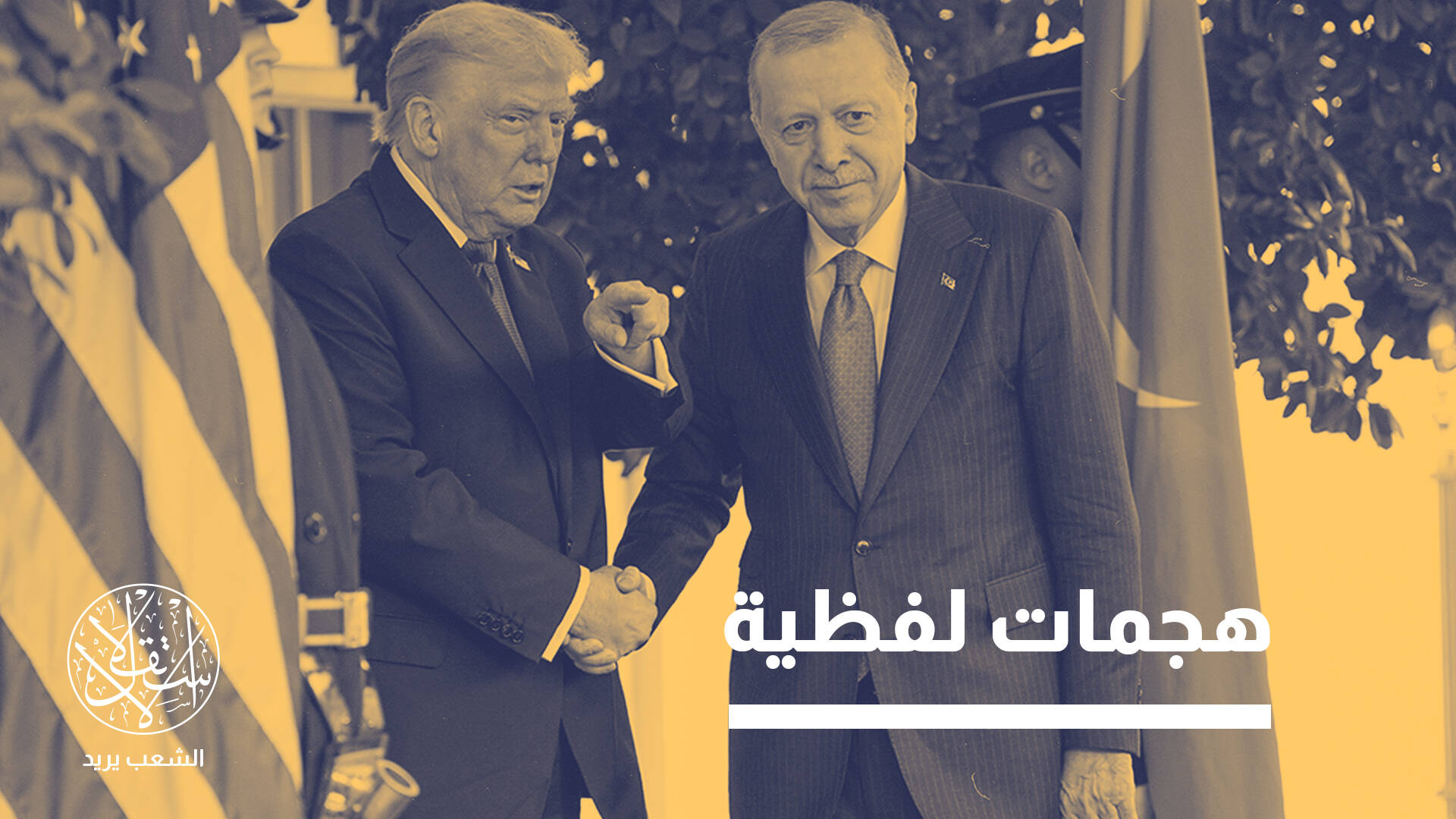ثقافة الفصل بين مفهوم الدولة والسلطة في الدول الديمقراطية

الدولة هي الوحدة القانونية والسياسية التي تتكون من ثلاثة عناصر وثلاثة أجهزة أو سلطات. أما عناصر الدولة فهي الإقليم والشعب والسلطة وفي أحيان معينة يكون الاعتراف بالدولة عند نشأتها من العدم مثل إسرائيل أو عند نشأتها بالانفصال مثل جنوب السودان أو كوسوفو، التى انفصلت عن الاتحاد اليوغوسلافي الذي تفكك إلى جمهوريات مستقلة أبرزها الصرب. ولم تنفصل كوسوفو عن جمهورية الصرب نفسها كما كانت الصرب تدعي في بداية الانفصال.
كما يكون الاعتراف مطلوبا للحكومات التي تنشأ بالانقلاب أو الحكومات التي تنشأ في نفس الدولة بالحروب الأهلية أو الثورية، كما هو حال رواندا حيث تغلبت الجبهة الوطنية الرواندية عام 1994 على نظام الهوتو بقيادة هابياريمانا، وسيطرت الجبهة بحكم التوتسي على البلاد فأصبح الاعتراف لازما لدولة قائمة تغيرت مكونات شعبها وحكومتها.
أما سلطات الدولة الثلاث فهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكانت الصحافة تلقب بالسلطة الرابعة على سبيل المجاز المستحيل تحقيقه في دول غير ديمقراطية حتى ظن الصحفيون فعلا أنهم سلطة فى مواجهة السلطات الأخرى وهم في الدول المتخلفة لسان الحاكم وصوته، ومن يتجرأ على غير ذلك فإن مصيره الفصل أو السجن أو قصف القلم والمنع من الكتابة، لأن السلطة التنفيذية عادة يغلب عليها العنصر الأمني أو الروح الأمنية التي تضع نفسها رقيبا حارسا لمصلحة المجتمع وضابطا لإيقاع الوطنية ضد كل صوت حر يوصم بأوصاف جاهزة في كل عصر أقلها تكدير السكينة العامة والعمالة والعمل لمصلحة الخارج المعادي وليس الخارج الحليف.
في الدولة الديمقراطية توجد عناصر الدولة وسلطاتها، ولكن ممارسة السلطة تتم وفقا للدستور والقانون الذي يحدد حدود السلطة وأنواعها ومن له الحق في ممارستها. فالبرلمان للتشريع ورقابة الحكومة والحكومة للإدارة وهي التي تظهر أمام الشعب والعالم بأنها تمارس السلطة، ولذلك فكل قراراتها قرارات إدارية يهيمن القضاء بدرجاته وأنواعه المختلفة عليها وفق قوانين واضحة تكفل تحقيق العدالة في الخصومات القضائية وتلتزم الحكومة قبل غيرها باحترام أحكام القضاء بحسن نية، وهو الأمر المعكوس تماما في الدول المتخلفة غير الديمقراطية أو الشمولية.
وقد تواتر في مصر استخدام اسم الدولة، فلا يجوز مصارعة الدولة أو الحرب ضدها ويجب احترام أوامرها ونواهيها. وأسرف الناس في استخدام مصطلح الدولة، بل زاد البعض عليه الجهات السيادية العليا. ففى عهد مبارك ظهر المصطلح ليشير إلى أنها رئاسة الجمهورية التي تتولى الجهات السيادية وغير السيادية، وينصرف المعنى أحيانا إلى الأجهزة الأمنية وهي في النهاية تحت هيمنة رئاسة الجمهورية وتأتمر بأمرها ويصاغ الخبر كما لو أن هذه الجهات السيادية هي الفيصل في حراسة مصالح الدولة العليا إذا التبس الأمر على كل السلطات والأجهزة الأخرى.
في دول العالم الثالث تفهم الدولة على أنها إرادة الحاكم، وهو عادة غير منتخب ولا سبيل إلى سلامة انتخابه لأنه السلطة؛ إما ملكا أو جاء تزويرا في إرادة الناخبين تزويرا ماديا أو معنويا. وتكون السلطة عادة بالغلبة وكل رموز السلطة من الموظفين والجنود والرسميين يمثلون هذه الدولة لأنهم يعملون بتعليمات الحاكم صاحب الدولة، ولا مانع أن يكون في الدولة دساتير رائعة وقوانين مبهرة تتحدث عن السيادة للشعب وكل هذه المصطلحات لا علاقة لها بالواقع.
ولكن المهم أنه لا يجوز معاندة الدولة لأنها باطشة، ليس بالقانون ولكن بفكرة أنه انتهاك للوائح وقواعد السلوك، وهي تحد للحاكم وخروج على سلطانه، وخلع للولاء له وربما خروج عن البيعة، وهذا هو السبب في احترام الأجانب في بعض الدول العربية لقوانين البلاد خاصة من العالم الثالث. أما مواطنو العالم الأول حلفاء الحاكم فمخالفتهم الجسيمة للقوانين مثل الإعدام لتهريب المخدرات أو القتل لها أسباب للتخفيف أو حتى للعفو مقابل الإبعاد حتى تتفادى هذه الدول التعقيدات الدولية في علاقاتها بدول هؤلاء المخالفين، خاصة وأن شعوب الدول الغربية لا تثق في قضاء العالم الثالث.
أما في مصر، ففكرة الدولة تاريخيا تنصرف مباشرة إلى الحاكم، وقد تكرس هذا المعنى في السياق التاريخي، فقد كان الحاكم في مصر ملكا وإلاها وكان الخروج على طاعته خروجا على إرادة الله.
كان ذلك سائدا في مصر الوثنية واستمر في مصر الإسلامية باجتهاد فقهاء السلطان، وصعوبة فك الاشتباك بين السياسة والدين على نحو صحيح وليس بطريقة انتقامية وتعسفية، طريقة تضمن للدين احترامه ومكانته ولكن تمنع الحاكم من استغلاله لتبرير استبداده، وهذه من لوازم الشعوب الإسلامية التي لم تعرف بعد الدولة الحديثة، وهذا هو السبب في أن الاتجاه الكاسح إلى تأكيد صورة الدولة المدنية الحديثة يقع في خلط واضح لأن الدولة بطبيعتها مدنية، أما نظام الحكم فيها وتداوله فهو الذي قد لا يكون كذلك.
وقد يقتصر الحكم على رجال الدين كما هو الحال فى الدستور الإيرانى. والدولة التي يحكمها رجال الدين أو العسكريون هي دولة مدنية لكنها بالقطع ليست ديمقراطية حتى لو توفرت فيها البيئة والعلامات الديمقراطية. ولذلك يتم التركيز على أن الدولة المطلوبة هي الدولة المدنية، وهذا تحصيل حاصل ثم أن تكون ديمقراطية، والديمقراطية تكون للنظام السياسي وليس للدولة ولكننا نصنف الدول إلى ديمقراطية واستبدادية بالنظر إلى نظامها السياسي.
ولذلك لا ضير في أن يصبح العسكري حاكما في الدولة الديمقراطية لأن الحاكم يصل إلى السلطة وفق النظام الديمقراطي، ويمارس السلطة وفق هذا النظام، فالنظام أقوى من الحاكم. ولا يكفى النص عليه في الدستور، ثم يفترق النص عن الواقع وإنما لابد من مؤسسات وقوانين وسلوك وثقافة ديمقراطية، وهي حزمة رباعية لا انفصال بينها. فإذا استقر هذا النظام وتغلب صار غالبا ومقيدا لأي حاكم مهما كانت خلفيته مدنية أوعسكرية.
ولكن الجيش والشرطة ليسا عادة هي الدولة في الدول الديمقراطية، لأن الضابط العام لتوزيع السلطة عند الجميع هو الدستور الذي يقدسه الجميع، وهو عقد بين أبناء الشعب يفوض الحاكم بمقتضاه أن يستخدم الجيش للخارج والشرطة للداخل، وإذا مارست الشرطة العنف خارج دائرة القانون كان تصرفها كتصرف العصابة التي تشكلت أصلا في غيبة القانون وترتبط شرعية استخدام القوة من جانب الشرطة بمدى كفاية غطائها القانوني، وإلا سقطت عنها هذه الشرعية وأصبحت أعمالها عدوانا إجراميا على حقوق المواطنين وحياتهم. أما الجيش فمستحيل أن يستخدم في الداخل إلا في الكوارث الطبيعية في الدول الديمقراطية.
إن الأولى بالإصلاح هو المجتمع وليس نظام الحكم، لأن المجتمع هو الوعاء الذي تخرج منه الحكومة وهو المخاطب بأحكام الدستور والقوانين وهو الضابط للدولة في معناها الأوسع، ولذلك فإن تدهور المجتمع يفرز أسوأ العناصر في حكمه ويحقق الانفلات فتصبح الشرطة أداة باطشة لحاكم فاسد لا رقيب عليه، كما أن ذلك المناخ بالإضافة إلى عداء إسرائيل لأي نظام ديمقراطي في المنطقة يجعل الجيش طرفا في العملية السياسية لشغله عن المواجهة عند اللزوم.