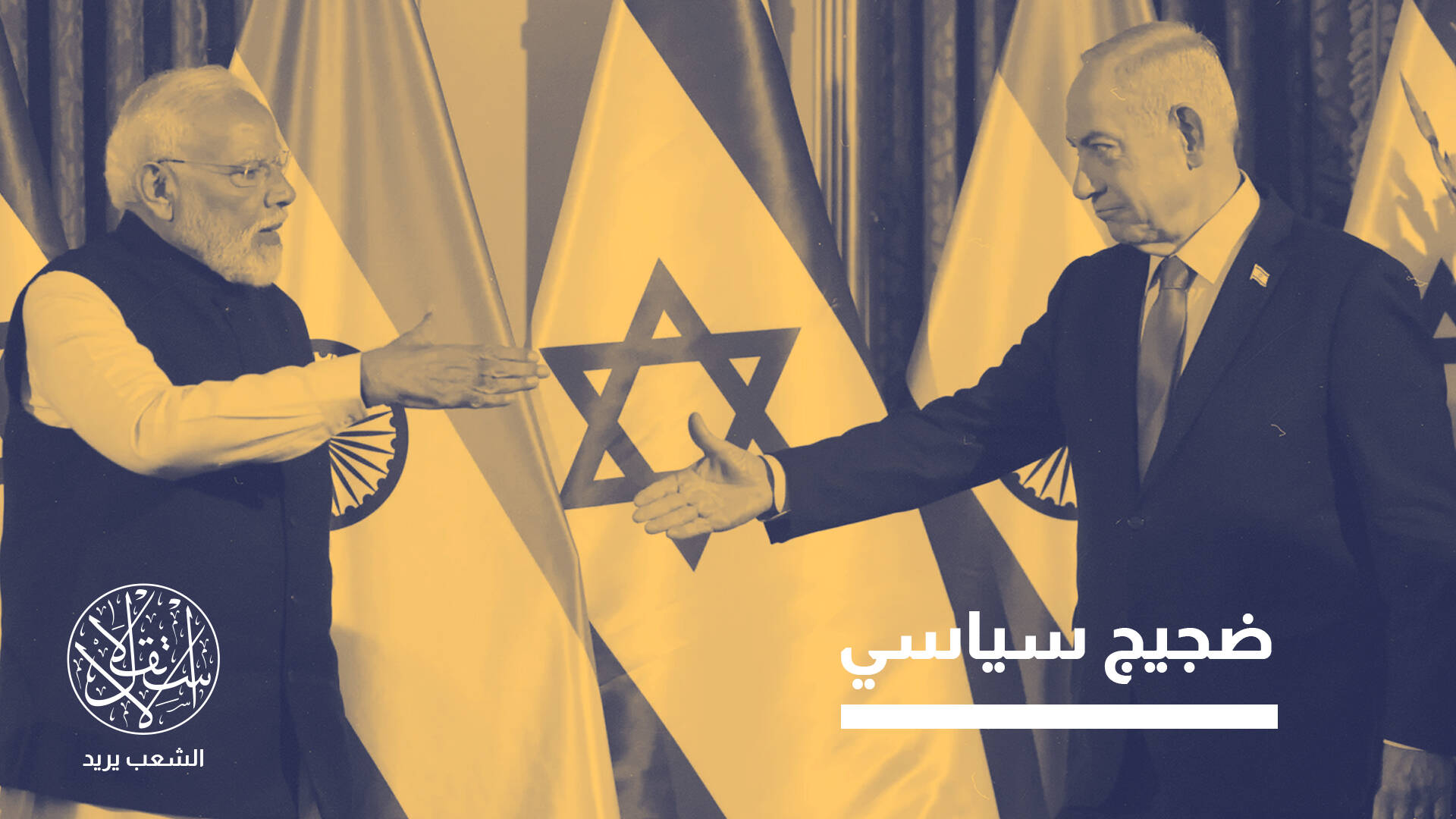ملف المياه بين تركيا والعراق.. من أداة ضغط سياسي إلى قاطرة تنمية

"وفق الاتفاق، تُستخدم عائدات الطاقة التي تستوردها تركيا من العراق في تمويل مشاريع مائية داخله"
لطالما شكلت المياه في بلاد ما بين النهرين عنصرا يتجاوز كونه موردا طبيعيا، ليغدو عاملا مؤسسا للحضارة، ومصدرا للصراع، وأحيانا مفتاحا لإعادة البناء.
في هذا السياق التاريخي والجغرافي بالغ الخصوصية، تبرز اتفاقية المياه الأخيرة بين تركيا والعراق بوصفها تطورا لافتا، ليس فقط في العلاقات الثنائية بين البلدين، بل في إعادة تعريف مفهوم إدارة الموارد المشتركة في الشرق الأوسط. بحسب الكاتب التركي "بيلجاي دومان".

منفعة مشتركة
وذكر الكاتب في مقال بمركز "فيكير تورو" التركي أن إشكالية المياه بين تركيا والعراق لم تكن وليدة العقود الأخيرة، بل تعود إلى مرحلة ما بعد انهيار الدولة العثمانية، حين تحوَّلت دجلة والفرات من نهرين داخليين في كيان سياسي واحد إلى أنهار عابرة للحدود بين دول مستقلة.
ومع نشوء تركيا والعراق وسوريا، أصبح تنظيم استخدام هذه الموارد ضرورة سياسية وقانونية، لكنه في الوقت ذاته تحوّل إلى ملف خلافي دائم. ففي حين غدا نهر الفرات قضية ثلاثية الأطراف، أصبح نهر دجلة محورا أساسيا للعلاقات التركية-العراقية.
وقد حاولت الاتفاقيات المبكرة، مثل اتفاقية أنقرة عام 1921 واتفاقية 1946 بين تركيا والعراق، وضع أسس تقنية للتعاون، شملت تبادل البيانات والسيطرة على الفيضانات.
غير أن محدودية التكنولوجيا في تلك المرحلة جعلت التركيز منصبا على تنظيم التدفق أكثر من التنمية الشاملة.
مع دخول العالم مرحلة "عصر السدود الكبرى" منذ خمسينيات القرن العشرين، تغيّرت طبيعة الخلاف.
فقد أصبحت مشاريع السدود جزءا من رؤية تركيا للتنمية والطاقة، بينما نظر إليها العراق بصفتها تهديدا لحصته المائية.
وتفاقمت هذه الحساسية مع مشاريع تركيا على نهر دجلة، رغم أن هذه السدود من الناحية الفنية لا تستهلك المياه بل تنظّم تدفقها، وهو ما يعود بالفائدة على دول المصب من خلال تقليل الفيضانات وتأمين جريان أكثر انتظاما في فترات الجفاف.
مع ذلك، تحوّل ملف المياه خاصة بعد عام 2003 إلى أداة ضغط سياسي وإعلامي ضد تركيا داخل العراق، بغضّ النظر عن المعطيات التقنية أو المنافع المشتركة.

غير أنّ ما يميّز المرحلة الراهنة في العلاقات التركية–العراقية هو التحوّل التدريجي من "منطق الصراع حول تقاسم المياه" إلى "منطق إدارة المنفعة المشتركة".
فهذا التحوّل لا يقتصر على تغيير في اللغة الدبلوماسية، بل يعكس إعادة صياغة شاملة لكيفية فهم الموارد العابرة للحدود بوصفها رافعة للتكامل، لا مصدرا دائما للتوتر.
فلطالما شكّل ملف المياه أحد أكثر ملفات العلاقة التركية–العراقية حساسية، خصوصا في ظل موقع تركيا كدولة منبع، والعراق كدولة مصب تعتمد بشكل شبه كامل على نهري دجلة والفرات.
لكنّ التطورات السياسية الأخيرة، لا سيما بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فتحت المجال أمام نمط جديد من التفاعل، يقوم على بناء الثقة المؤسسية وربط الملفات الخلافية بسياقات تعاون أوسع.
حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال العامين الأخيرين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي والمؤسسي، تُرجم هذا التقارب بسلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت الأمن، والتجارة، والنقل، والطاقة، وصولا إلى المياه.
في هذا الإطار، لم يعد ملف المياه يُدار بوصفه قضية خلافية معزولة أو ورقة ضغط متبادلة، بل جرى إدماجه ضمن رؤية إستراتيجية أشمل للتعاون الاقتصادي طويل الأمد.
ويُعد توقيع "آلية تمويل مشاريع التعاون المائي" خطوة مفصلية في هذا الاتجاه.
فهذه الآلية لا تكتفي بوضع مبادئ عامة أو إعلان نوايا، بل تنقل التعاون المائي إلى مرحلة التنفيذ العملي، بما في ذلك تحديد مصادر التمويل، وآليات التنفيذ، ودور الشركات، والجدول الزمني.
وهو ما يعكس درجة متقدمة من النضج في دبلوماسية المياه بين البلدين، مقارنة بالنماذج السابقة التي غالبا ما بقيت حبيسة الإطار الخطابي.
قاطرة تنمية
وأشار الكاتب التركي إلى أن الابتكار الأبرز في الاتفاقية الجديدة يتمثل في الربط البنيوي بين ملف المياه وملف الطاقة.
فبدل أن يبقى الماء موضوعا للتجاذب السياسي أو المساومة الظرفية، يجري تحويله إلى محور دورةٍ تنموية متكاملة تقوم على تبادل المنافع.
وفق هذا النموذج، تُستخدم عائدات الطاقة التي تستوردها تركيا من العراق في تمويل مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية.
وهي مشاريع تنفذها شركات تركية متخصصة في مجالات السدود، وشبكات الري الحديثة، ومعالجة المياه، والحد من الهدر.
بذلك يجرى تجاوز أحد أهم عوائق التنمية في العراق، وهو نقص التمويل، دون اللجوء إلى قروض خارجية أو شروط مؤسسات مالية دولية.
وتنتج هذه المعادلة سلسلة إيجابية مترابطة: الطاقة تموّل المياه، والمياه تدعم الزراعة والأمن الغذائي، والزراعة تعزّز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الطاقة وتعميق الشراكة الاقتصادية.
على هذا الأساس تنتقل العلاقة من نقاش حول "كم مترا مكعبا من المياه" إلى شراكة في التنمية المستدامة، تحمل أبعادا سياسية وأمنية بعيدة المدى، أبرزها تقليص دوافع عدم الاستقرار في مناطق الهشاشة الاقتصادية.

ولا يمكن فصل هذا النموذج عن أبعاده السياسية والأمنية. فإنّ تعزيز التنمية الزراعية والمائية في العراق، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، يحدّ من الهجرة الداخلية ويقلل من قابلية هذه المناطق للاختراق من قبل الفاعلين غير الدوليين.
كما أن توسيع الاعتماد المتبادل بين أنقرة وبغداد يخلق حوافز قوية للحفاظ على الاستقرار السياسي، ويجعل أي تصعيد محتمل مكلفا للطرفين.
من جهة أخرى، يمنح هذا النموذج تركيا دورا جديدا، لا بوصفها دولة تتحكم بمصادر المياه فحسب، بل كشريك في إعادة بناء البنية التحتية العراقية، وهو ما يعزز نفوذها الإقليمي بأدوات اقتصادية وتنموية بدل الأدوات الصلبة.
ولا تقتصر أهمية هذا النموذج على الإطار الثنائي بين تركيا والعراق، بل يحمل إمكانية التوسع إقليميا؛ إذ يمكن أن يشكّل مرجعا عمليا للتعاون مع سوريا في المستقبل، خصوصا فيما يتعلق بإدارة مياه نهر الفرات، وذلك في حال توفرت الظروف السياسية الملائمة.
بهذا المعنى، قد تتحول دبلوماسية المياه في المشرق من مصدر هشاشة وصراع مزمن إلى منصة لبناء الثقة والتكامل الإقليمي، بحيث تقوم على الربط بين الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية بدل اختزالها في معادلات السيادة والصراع.
وختم الكاتب مقاله قائلا: إن اتفاقية المياه بين تركيا والعراق تتجاوز كونها ترتيبا تقنيا لإدارة مورد طبيعي، لتغدو تعبيرا عن تحوّل أعمق في الذهنية السياسية تجاه الموارد المشتركة.
فهي محاولة واعية لنقل فكرة "النهضة" التي عرفتها ميثولوجيا بلاد ما بين النهرين، بحيث يولد النظام الجديد من قلب الأزمة إلى واقع السياسة المعاصرة. وإذا كُتب لهذه الآلية أن تُنفّذ بجدية واستمرارية، فإنها قد تمثل بداية فصل جديد في تاريخ المنطقة.