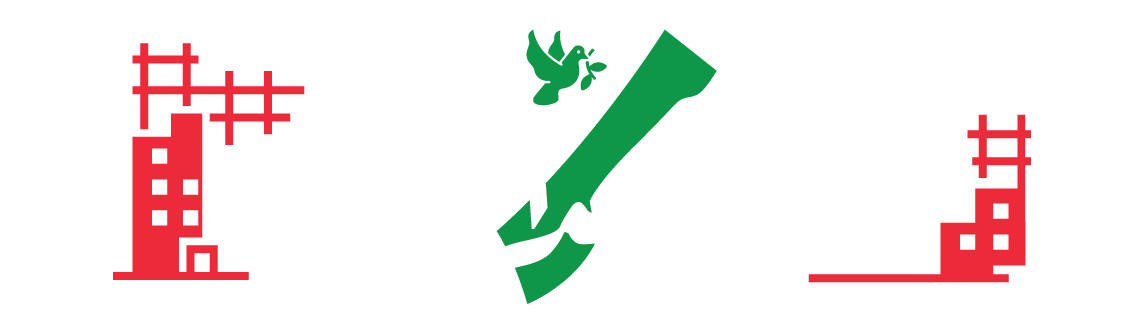جهود باءت بالفشل.. كيف حاولت فرنسا على مدى عقود تشكيل إسلام علماني؟

"مساعي جمع كل الأفكار الدينية الإسلامية تحت سلطة واحدة فرنسية باءت بالفشل"
كيف سعت الحكومات الفرنسية إلى تنظيم الإسلام وشؤون المسلمين داخل البلاد، في ظل مواجهتها تحديات سياسية واجتماعية، خاصة مع تزايد الهجرة من دول شمال إفريقيا وتأثير الدول الأجنبية على المؤسسات الإسلامية؟
سؤال طرحته مجلة "جون أفريك" الفرنسية في مطلع تقرير لها بخصوص وضع الإسلام في فرنسا قديما وفي الوقت الراهن.
فرغم محاولات الدولة الفرنسية للحد من هذا النفوذ وخلق "إسلام فرنسي" متوافق مع قيم العلمانية، أدت القيود المفروضة إلى زيادة الشعور بالاستهداف لدى المسلمين.
وفي ظل هذا الجدل، تتساءل المجلة: “هل يمكن لفرنسا تحقيق نموذج إسلامي مستقل، أم أن الإسلام سيظل مرتبطا بجذوره الخارجية ويشكل محورا للخلاف السياسي والاجتماعي؟”

موجات الهجرة
تبدأ المجلة تقريرها بالقول إن مؤسسة الحسن الثاني في عام 2025 أرسلت للمغاربة المقيمين في الخارج 272 واعظا إلى أوروبا.
حيث تحظى فرنسا بالنصيب الأكبر بـ 75 واعظا، مقارنة بـ 40 فقط لألمانيا، رغم أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 5 ملايين مسلم في هذين البلدين من أوروبا الغربية.
ويعود هذا التفاوت، وفقا للمؤسسة المغربية، إلى التاريخ الاستعماري، الذي دفع المهاجرين من شمال إفريقيا إلى التوجه بشكل أساسي نحو المستعمر السابق، مما جعل الإسلام في فرنسا إسلاما مغاربيا بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المجلة إلى أن "الإسلام رغم استقراره في فرنسا خلال القرن العشرين ليصبح الديانة الثانية بعد المسيحية، إلا أن وجوده في البلاد أقدم من ذلك بكثير".
وتلفت المجلة إلى أن "تحديد أصوله يتطلب العودة إلى القرن الثامن، حين اجتاحت الفتوحات العربية الإسلامية جبال (البرانس) قادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية، أو عبر البحر المتوسط إلى منطقة (بروفانس ألب كوت دازور)".
وفي هذا الصدد، تنقل المجلة عن عالم الأنثروبولوجيا جان-فرانسوا كليمان أن "الإسلام تغذى في فرنسا عبر خمس موجات هجرة رئيسة، منذ العصور الوسطى العليا وحتى اليوم، وهو ما يستدعي استعراض هذه المراحل التاريخية بالتفصيل".
وتابع: "تعود الموجة الأولى إلى عام 716، عندما دخل جنود الخلافة إلى أراضي ما سيصبح لاحقا فرنسا، واستقرت مجموعة صغيرة من العائلات المسلمة في مدينة ناربون".
"وبعد حوالي قرنين، استهدف المسلمون منطقة أخرى، وهي بروفانس، لكن هذه المرة لم تكن دوافعهم روحية، بل اقتصادية بحتة"، بحسب ما ورد عن المجلة.
وأردفت: "حيث استقرت هناك مجموعات صغيرة تسعى للثراء، تتكون من بضع عشرات من العائلات المسلمة القادمة من المغرب، في المنطقة التي سُميت لاحقا بـ (جبال المورو)".

وبالإشارة إلى أن "الوجود الإسلامي في جنوب فرنسا لم ينقطع من العصور الوسطى حتى العصور الحديثة"، تذكر المجلة أن "عدة مجتمعات صغيرة من التجار المسلمين أُقيمت في عدة موانئ فرنسية، وكان أشهرها مدينة مارسيليا، حيث كان لهم أحياؤهم ومساجدهم".
وفيما يخص آخر موجة، تقول المجلة: إن "هذه الموجة من الهجرة المسلمة إلى فرنسا بدأت في أواخر القرن التاسع عشر واستمرت طوال القرن العشرين".
وكما يشير المؤرخ أنور لوكا، فقد عاد بعض الجنود المصريين المسلمين إلى فرنسا مع نابليون بونابرت، رغم أن هذا الحدث ظل هامشيا.
ولكن بدأت الهجرة الفعلية بعد عام 1830 مع استعمار الجزائر، حيث كان الجزائريون أول من هاجر إلى فرنسا، ثم تبعهم التونسيون والمغاربة مع توسع ما عُرف بـ "إفريقيا الشمالية الفرنسية".
جدير بالذكر أن هذه الهجرة في البداية كانت تتكون من تجار، لكنها سرعان ما أصبحت تعتمد بشكل أساسي على العمال، وغالبا ما كانت تتم بمبادرة من أصحاب العمل الفرنسيين.
أول مؤسسة إسلامية
وبالعودة قليلا إلى الوراء، تقول "جون أفريك": إنه "مع اندلاع الحرب العالمية الكبرى، ازدادت حاجة الجيش الفرنسي إلى الجنود من المستعمرات، مما جعله أول مؤسسة تواجه مباشرة مبادئ الإسلام".
وفي هذا السياق، اعتمدت المؤسسة العسكرية على اللجنة الحكومية المشتركة للشؤون الإسلامية "CIAM"، التي أُنشئت عام 1911.
ووفقا لما ورد في "المجموعة العامة للقوانين والأحكام" الصادرة في 1 يناير/ كانون الثاني 1938، كانت "CIAM" بمثابة هيئة استشارية مكلفة بدراسة القضايا العامة المتعلقة بالسياسات الإسلامية.
وعندما كانت تُناقش مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية أو المصالح الدينية والأخلاقية للمسلمين، كان يُضاف إلى اللجنة أعضاء مسلمون من الجزائر للمشاركة في الاستشارات، بحسب ما ورد عن المجلة.
ومنذ بدايتها، حسب المجلة، "كانت اللجنة الحكومية المشتركة للشؤون الإسلامية "CIAM" خاضعة لهيمنة الإسلام الجزائري، مما جعلها العمود الفقري للسياسة الإسلامية في فرنسا".
وفي هذا الإطار، تذكر المجلة الفرنسية أنه "خلال الحرب العالمية الكبرى، جُند 175 ألف جزائري و85 ألف مغربي و62 ألف تونسي للقتال تحت راية العلم الفرنسي".
وذلك إلى جانب الجنود السنغاليين المسلمين والعمال المسلمين الذين دعموا المجهود الحربي من الخطوط الخلفية.
وبشكل عام، تذكر المجلة أن "أقدام ما لا يقل عن 600 ألف جندي وطأت من المستعمرات الأراضي الفرنسية بين عامي 1914 و1918".
ونتيجة لذلك، أمام هذا العدد الكبير من الجنود المسلمين، اضطرت القيادة العسكرية الفرنسية إلى تكييف أوضاعهم المعيشية.
ومن أجل الحفاظ على روحهم المعنوية، تقول المجلة: إن "الضباط الفرنسيين شجعوا على ممارسة شعائرهم الدينية، بل عملوا على توفير أماكن مخصصة لذلك".
علاوة على ذلك، تبرز المجلة أنه خلال الحرب العالمية الأولى، ترك الإسلام بصمته على التراث الفرنسي، إذ بُني مسجد في الحديقة الاستعمارية في "نوجان-سور-مارن" عام 1916.

وبعد عقد من الزمن، افتُتح مسجد باريس الكبير عام 1926 تخليدا لذكرى 36 ألف مسلم من شمال إفريقيا قُتلوا في الحرب (1914-1918).
وتنقل المجلة عن بيير فيرمرين في كتابه "تاريخ الجزائر المعاصرة" قوله: إن "افتتاح المسجد كان بمثابة عملية دعائية كبرى استهدفت المسلمين داخل المستعمرات الفرنسية وخارجها، وكذلك الجمهور الفرنسي".
وحسب المجلة الفرنسية، منذ ذلك الحين، أصبح للإسلام في فرنسا تمثيل وطني ودولي، وكان أول إمام رسمي لفرنسا هو الشيخ قدور بن غبريط (1868-1954)، وهو عالم دين جزائري الأصل.
جدير بالذكر أنه وُلد في الجزائر لكنه نشأ في المغرب الأقصى حيث شغل مناصب رفيعة، سواء في البعثة الدبلوماسية الفرنسية في طنجة أو في القصر الملكي المغربي.
وبعد وفاته، كتبت عنه مجلة "لوموند" الفرنسية: "لم يكن قدور مجرد دبلوماسي، فقد كرس حياته على مدار ثلاثين عاما لخدمة المعهد الإسلامي "مسجد باريس"، حيث بذل جهودا كبيرة لصالح أبناء دينه من جميع الطبقات".
وهكذا، بحسب المجلة، كان قدور بن غبريط هو من منح الإسلام الفرنسي طابعه المغاربي، ليصبح مسجد "باريس" رمزا لهذا الوجود الإسلامي في فرنسا.
"إسلام فرنسي"
وإكمالا لما سبق ذكره، تظهر “جون أفريك” أنه "في النصف الثاني من القرن العشرين، شكل العمال المهاجرون من شمال إفريقيا النسبة الأكبر من الأيدي العاملة الوافدة إلى فرنسا، لسد احتياجات إعادة الإعمار والتصنيع بعد الحرب العالمية الثانية".
ورغم التوترات بين مسجد "باريس" ودول المغرب العربي، ظل المسجد المؤسسة الرئيسة التي ترعى الإسلام في فرنسا، مستفيدا من دعم مالي من بلدية باريس ووزارة الداخلية الفرنسية.
ولكن في السبعينيات، أدت الأزمات النفطية والركود الاقتصادي إلى تشديد سياسات الهجرة، مما جعل الإسلام في فرنسا ينغلق على نفسه، وفق المجلة.
وبهذا الشأن، تنقل المجلة عن الفيلسوف، ألان بوييه، قوله في كتابه "الإسلام في فرنسا": "استقرار العائلات المسلمة في فرنسا بشكل دائم جعل الإسلام جزءا من المشهد الديني الفرنسي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الممارسات الدينية، مثل أداء الصلوات وصيام رمضان".
وتابع: "كما استلزم بناء أماكن عبادة وإنشاء مقابر إسلامية وإيجاد حلول لمسائل تكوين الأئمة وتمويلهم وتوفير كوادر دينية للتعليم والإرشاد وقيادة الصلوات".
وهكذا، ترى المجلة أن "اندماج الإسلام في فرنسا أصبح مسألة تنظيمية ودينية واجتماعية معقدة، وسط تحديات مستمرة لتحقيق (إسلام فرنسي) متكيف مع بيئته الجديدة".
وبعد ذلك، توضح المجلة أنه "منذ ثمانينيات القرن الماضي، تزايدت المطالبة بإيجاد إسلام منظم ورسمي مع مرور الوقت".

وبالفعل، استجاب رئيس الوزراء، ريمون باري، لهذا الطلب من خلال تأسيس اللجنة الاستشارية للمسلمين في فرنسا بموجب مرسوم.
ثم جاء الوزير الاشتراكي بيير جوس، الذي بدأ في عام 1988 العمل على إعطاء الجامع الكبير في باريس مكانته الفرنسية بعيدا عن تأثير الجزائر.
وقد أدى ذلك -بحسب المجلة- إلى "إنشاء مجلس التفكير حول الإسلام في فرنسا (كوريف)، الذي كان يعمل على فرنسة وعلمنة الإسلام في فرنسا لجعله (إسلاما فرنسيا)".
بالإضافة إلى ذلك، دفع تشارلز باسكوا، وزير الداخلية بين 1993 و1995، وزارة الداخلية نحو إنشاء هيئة استشارية للشؤون الإسلامية.
وهو ما تحقق مع المجلس الاستشاري للمسلمين في فرنسا، ثم المجلس التمثيلي للمسلمين في فرنسا، الذي كان يهدف إلى جمع جميع الأفكار الدينية الإسلامية في البلاد تحت سلطة واحدة.
ورغم كل هذه الجهود، تبرز "جون أفريك" أنه "بعد ربع قرن، لا يزال الإسلام في فرنسا، الذي يُعد ثاني أكبر ديانة في البلاد، مجزأ".
وتختتم المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزراءه، قد تولوا مواصلة هذه الجهود، ولكن دون نجاح كبير حتى الآن".